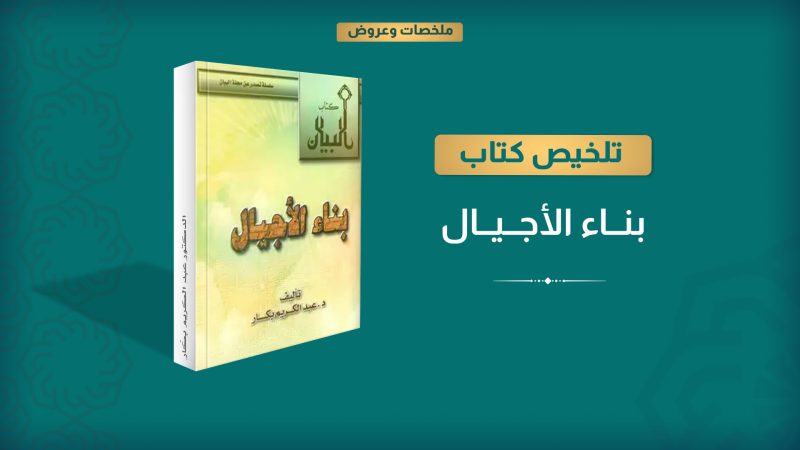المؤلف: د. عبد الكريم بكَّار
الناشر: مجلة البيان- المملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى- 1423هـ/ 2002م
الفكرة الأساسية التي يدور حولها الكتاب-كما يقول المؤلف- تتركز في أنه: “علينا أن نبذل ما نستطيع من جهد في سبيل إثارة اهتمام المسلمين نحو قضايا التربية والتعليم؛ بوصفها القضايا الأكثر فاعلية في تشكيل ملامح الأجيال الجديدة”.
يبدأ الكتاب بالحديث عن أهمية الارتقاء بالتربية والتعليم، ويرجعه إلى فهم الإسلام والتفاعل معه، بالإضافة إلى الانفتاح على التقدم العلمي الهائل، الذي نحن بحاجة إلى مواكبته والإفادة من نتائجه في نهضة الأمة الإسلامية.
ثم يطرح الكتاب سؤالًا يتعلق بأي جيل نبني؟ ويحاول الإجابة على هذا السؤال بالحديث عن مقومات الجيل المنشود الذي نتطلع إليه. وهذه المقومات بمثابة الأسس التي يجدر بالمربين والمعلمين تحقيقها في الأجيال الذين نستهدف تكوينهم وفق منهج التربية الإسلامية.
ويختار المؤلف عددًا من الموضوعات المترابطة التي تمثل- من وجهة نظره- كلًّا متكاملًا لوضع ملامح لتكوين الأجيال الجديدة. فتحدث عن القيم المهمة التي يدركها المربي الحصيف من خلال ثقافته الإسلامية وزاده المعرفي. ثم تحدث عن البيئة التربوية وبخاصة البيئة التعليمية التي تقوم بوظائف تربوية في إعداد الناشئين والطلاب. ثم تكلم عن بناء العقل ومستوى المعرفة والتثقيف لدى الجيل المسلم الجديد، وشخصية المعلم، وعلاقة المعلم بالطالب، وأسلوب التعليم. والتحديات الأساسية التي تعاني منها التربية في البيوت والمدارس، وختم الكتاب بتوصيات تساعد في التجديد التربوي.
يتكون هذا الكتاب من مقدمة، وأحد عشر موضوعًا، هي: أي جيل نبني؟، ومبادئ ومفهومات مهمة، وقيم أساسية، والبيئة التربوية، وبناء العقل، وجيل يعرف، وشخصية المعلم، وعلاقة المعلم بالطالب، وأسلوب التعليم، وثلاثة تحديات، وآفاق التجديد التربوي.
مقدمة الكتاب
يعرض المؤلف في المقدمة أهمية الارتقاء بالتربية والتعليم؛ فهي الأكثر فاعلية في تشكيل ملامح الأجيال الجديدة. يقول: “نركز اليوم على ضرورة رفع سوية التعليم، وتحسين مستوى الدراسي في المدارس والجامعات؛ وإن قيمة ما تقدمه مدارسنا ومعاهدنا من تربية وعلم وتدريب لن تكون مطلقة، وإنما بالقياس إلى ما تقدمه المؤسسات التعليمية لدى الدول الصناعية”.
ثم ينتقل المؤلف إلى أهمية الارتقاء بالتربية والتعليم، ويرجعها إلى الآتي:
1- فهم الإسلام والتفاعل مع مبادئه وأطره وآدابه.
2- التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم في كل لحظة؛ أعطى للتعليم أهمية إضافية.
3- بعد التقدم العلمي الهائل الذي توصلت إليه الأمم المتقدمة، صار من مسؤوليتنا الكبرى أن نسعى إلى ترويض أنفسنا وأسرنا وطلابنا على استخدام المنتجات التقنية الحديثة فيما يعود علينا بالنفع والرقي.
4- قدرات الإنسان لا تبرز إلا من خلال تحمل المشاق التي نجدها في التعليم والتدريب والتنظيم؛ وعلى مؤسساتنا العلمية أن تزود الطلاب بالمزيد من الحكمة والفهم تجاه مغريات الحضارة الحديثة.
5- العلم وحده هو الذي يصنع الفرق في أحاسيس الناس واستجاباتهم تجاه الفرص والتحديات التي يتعرض لها الإنسان، والبنية المعقدة للحياة المعاصرة لا تُحلُّ إلا من خلال التثقيف.
أي جيل نبني؟
يسأل المؤلف: أيُّ جيل نبني؟
ويؤكد أن هذا السؤال من أكثر الأسئلة مركزية وجوهرية في مقام التربية؛ حيث إن معرفة المواصفات التي يجب أن تتوفر في الجيل القادم- تعد أكبر مساعد لنا على معرفة نوعية الاهتمامات التي سنثيرها في نفوس أبنائنا وطلابنا، ونوعية الأنماط السلوكية التي نوجههم إليها، والأفكار والمعطيات الثقافية التي نحفزهم على تشربها.
ويشير المؤلف إلى دور القائم بالعملية التعليمية، وأن عدم وضوح الهدف من التربية لديه أو عدم حضور الهدف في الممارسة التربوية اليومية، وعدم الإلمام بالأهداف الأساسية إلى جانب عدم وجود ثقافة تربوية جيدة لدى كثيرين ممن يمارس التربية = يؤدي إلى عدم تناسق الجهود التربوية وتصادمها.
ويعرف المؤلف التربية الإسلامية بقوله: “إن التربية الإسلامية في البيوت والمساجد والمدارس تستهدف تكوين (المسلم الحق) الذي يعيش زمانه في ضوء العقيدة والمبادئ التي يؤمن بها”.
ويسرد المؤلف عددًا من النقاط التي بلغت أربعًا وعشرين نقطة، هي بمثابة المقومات أو الأسس التي يجدر بالمربين والمعلمين تحقيقها في الأجيال الذين نستهدف تكوينهم وفق منهج التربية الإسلامية، ويمكن تلخيصها في ستة محاور أساسية: المحور الإيماني والتعبدي، والمحور الأخلاقي والسلوكي، ومحور الانتماء، والمحور الذاتي، والمحور التدريبي، والمحور المعرفي والعلمي. ومن أهم النقاط الواردة فيها:
- تعريف الناشئة على الله جل جلاله، وإخلاص العبادة لله وحده، وغرس حب الله ورسوله فيهم.
- تنشئة الأبناء على الأخلاق الفاضلة كالصدق، والأمانة، والإحسان، والصبر، وتوقير الوالدين، وصلة الأرحام، وبذل المعروف، ونصرة المظلوم، والوقوف إلى جانب الضعيف، والعفو والتسامح.
- تعزيز روح الانتماء إلى أمة الإسلام، والمجتمع الذي يعيش فيه. وبث روح الإصلاح فيهم.
- مساعدة الطالب على اكتشاف مهاراته وقدراته، وإشعاره بضرورة تحمل المسؤولية، والنتائج المترتبة على قراراته.
- تنمية قدرات الطلاب على الملاحظة، ورؤية الارتباط بين الأسباب والمسببات، والمقدمات والنتائج.
- تدريبهم على الاستخدام الصحيح للغة العربية.
- تدريبهم على الحلول البديلة، ومساعدتهم على رسم أهدافهم، وتحديد أولوياتهم. وتدريبهم على امتلاك أسس المرونة الذهنية، وتكوين الإنسان الحر، ودلالة الطالب على المقومات التي تجعله ناجحا في حياته، وتهيئته ليكون قادرا على كسب رزقه من خلال التلاؤم مع سوق العمل.
- تخليص أذهان الطلاب من الأوهام والمعتقدات والأفكار الخاطئة، وتحفيزهم على حب الاستطلاع، وتكوين النظرة العلمية، والعقل المثقف، والتعليم المستمر، وتعزيز الاحترام للمعرفة، وتعزيز فهم الطالب للواقع وما يدور في حياته والعالم من حوله، وإظهاره على أسرار التقدم، ومكامن الغلبة لدى الأمم المتقدمة.
مبادئ ومفهومات مهمة
تنطلق البيوت والمدارس في تربيتها للأجيال من مجموعة من المبادئ والمفهومات. ويستعرض المؤلف من هذه المفهومات والمبادئ ما يَعدُّه مهمًّا في تشكيل خلفية مفهوماتية للتربية في النقاط الآتية:
- عصر جديد: يعيش العالم الإسلامي اليوم في مركز إعصار العولمة، وأمة الإسلام لها طريقها الخاص في الحياة، إنها ذات هوية خاصة، وهذه الهوية تتعرض للمخاطر أكثر فأكثر كلما زادت الحياة تعقيدا. والهوية تنطمس معالمها في أذهان الناشئة في ظل انعدام التكافؤ الإعلامي بين الداعين إلى ترشيح الهوية الإسلامية، وبين المطبلين للعولمة.
ويضيف المؤلف: وأعتقد أن الأمة لن تستطيع المحافظة على أبنائها إلا من خلال تحسين أدائها الإعلامي والتربوي؛ ليكون أصيلا ومعاصرا في آن واحد. وهذا يقتضي الاهتمام بتوعية الجيل بخصوصية أهداف الأمة في هذه الحياة، وإدارة الإمكانات المتاحة على نحو جيد، والانفتاح ومحاولة فهم المتغيرات الحاصلة، والاستعداد إلى الارتحال والانتقال من بلد إلى بلد، ومن وظيفة إلى أخرى، ولا يكون ذلك إلا بتدريب الناشئة على التلاؤم مع البدائل والفرص الجديدة.
- تشجيع المبادرة الحرة: فالأعمال الحضارية الكبرى لا تقوم إلا عن طريق الحماسة والرغبة والمبادرة الحرة، وأن الأمم العظمى لا تشيد صروحها الحضارية عن طريق فرض القيود والمنع والزجر والتخويف. وعلى هذا يجب أن يكون بناء الوعي لدى طلابنا.
- مباهج الحياة: الحضارة الحديثة جعلت المادة هي كل شيء، ولا شك في أن المال ضروري للحياة، بل هو عصب الحياة، لكن نظرة المسلم يجب أن تتفق مع نظرة الإسلام بالنسبة للمال، فالمرء يمكنه أن يستمتع بمتع أخرى – غير المال- كمتعة القراءة، ومناصرة الحق، والتعبد لله عز وجل، ونشر المبادئ، وغيرها. ومن المهم أن نقوم بالعمل بجدية على توجيه الناشئة نحو الإقبال على تحقيق سعادة لا تحتاج إلى المال ولا تخل المرء في صراع مع الآخرين.
- مجتمع مستنير: من العسير أن تتقدم التربية في المدارس على النحو الذي نريد إذا لم يحدث تقدم اجتماعي عام، بترتيب أوضاعنا الاجتماعية وصوغ حياتنا اليومية على هدي العلم والمعرفة.
- لا بديل عن السعي إلى التمدُّن: الذي يعني ارتقاء أهداف الإنسان وثقافته وفكره، وتعامله، وتحقيق لذاته، وطريقة حله لمشكلاته. وذلك وفق منظور الإسلام، وانعكاس ذلك في حياتنا اليومية أمام الناشئة.
- الحوار لا المناظرة: نحن بحاجة ماسة إلى الحوار، وبخاصة في المجال التربوي مع طلابنا.
- الحذر من إدارة معطيات العلم: علينا أن ننبه الأجيال الجديدة إلى أن المستقبل سوف يشهد المزيد من الاستخدام السيء للمعطيات العلمية؛ ولهذا فعلينا أن نتعامل مع معطيات العلم بحذر، وألا نثق في كل ما ينشر ويقال عنه، ونعلم ذلك للأجيال.
- تربيتنا مرآة لنا: فكما يكون الآباء تكون تربيتهم، ولهذا فالاستقامة الشخصية لأفراد الأسرة هي وحدها التي تجعل تكوُّن شخصية الطفل تتم على النحو الصحيح.
- تأسيس حب النظام: بترسيخ حب النظام في نفوس الطلاب، والتأكيد على احترامه، والالتزام به في سلوكهم وعلاقاتهم. وأن يستطيع الطفل التفريق بين الخطأ والصواب بتأسيس نظام القيم لديه.
قيم أساسية
يقول المؤلف هناك الكثير من القيم المهمة التي لا يتسع المقام للحديث عنها، ولكن يدركها المربي الحصيف، من خلال ثقافته الإسلامية وزاده المعرفي. ومن خلال مشاهداته للانحرافات والمشكلات التي يقع فيها أبناؤه وطلابه. ومن هذه القيم:
- الإيمان الحي: نريد ترسيخ الإيمان بالله- جل وعلا- ليس بوصفها قناعات عقلية، ولكن بوصفه مشاعر وأحاسيس، بمراقبة الله تعالى، والخضوع والاستسلام له، والاغتباط بفضله وإحسانه.
- النية الصالحة: بأن يكون طلب العلم لله تعالى؛ فطلب العلم وتعليمه من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه.
- الابتهاج بمعرفة الحقيقة: إن نصرة الحق ونشره وتقريره من المهمات الكبرى للمسلم في هذه الحياة.
- التحرر من القيود: إذا أرادت مؤسساتنا التعليمية أن تنشئ جيلا حرا، فلتحاول تحسين مستوى التفكير لديه، وتنمية الوازع الداخلي الذي يشكل نواة الإرادة الصُّلبة، وتنمية مهاراته، وتكوين النفسية الإيجابية لديه.
- الشعور بالمسؤولية: أن نغرس في الجيل الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه ودينه وأهله ومجتمعه من القيم الجوهرية.
- فضيلة المثابرة: قيم المثابرة على العمل والاستمرار في بذل الجهد، وتركيز الاهتمام- باتت أهم في إحراز السبق والتفوق على الأقران، من الذكاء الذي يرثه الإنسان عن أبويه وأجداده.
- التميز الحقيقي: أمة الإسلام بحاجة إلى جيل، لا أقول متميزا، ولكن فيه شريحة جيدة من المتميزين الذين يتسمون بسمات أرقى مما هو سائد بين الأقران.
- روح الفريق: لا بد من تعويد طلابنا على العمل بروح الفريق، فهذا من طبيعة التقدم الحضاري.
- المال ليس أكثر من وسيلة: على المربين أن يعلموا الأجيال أن الثروة الحقيقية والمتجددة في حياة الأفراد تقوَّم من خلال نوعية الدوافع التي يمتلكونها، والاهتمامات التي تسيطر عليهم. ولهذا فالذي يملك الدوافع القوية لعمل الخير، والارتقاء بذاته، وإحراز التفوق والنجاح، يملك مفاتيح الحياة الطيبة التي تستخدم المال في تحقيق ذاتها.
- محاربة الغرور: يحتاج الجيل الحالي أن يحتفظ برؤية معتدلة لنفسه وللناس من حوله، والاعتدال والتوسط من الأمور التي تحتاج إلى تشغيل الذهن ومجاهدة النفس في آن واحد.
- الرفاهية الروحية: إننا بحاجة ماسة إلى أن ننمي في نفوسنا معاني التضحية والإيثار والعطاء المجاني؛ حتى نستطيع مقاومة التيار الأناني الذي يجتاح حياة الأمة.
- الوفاء بالوعد: من القيم المهمة التي لا تستقيم حياتنا الاجتماعية من غيرها قيمة الوفاء بالوعود والعهود والعقود، وإلا فقدت الثقة بين الناس في المجتمع.
- التفوق والنجاح: الحرص على التفوق والنجاح والارتقاء المستمر- من المعاني المهمة التي ينبغي أن يحملها أبناء الجيل الجديد.
- الانتماء لأمة الإسلام: عملت العولمة – بقصد – إلى محاولة تفكيك الأسرة، وتفكيك الأمة؛ وبدأت مظاهر التفكك تتجسد لدينا في حياة كثير من الشباب، من حيث الاهتمام الزائد بالأمور الشخصية وضعف الاهتمام بالشأن العام، وضعف روح الانتماء للأمة وللمجتمع الذي يعيشون فيه.
البيئة التربوية
كل إنسان مدين في تركيبته العقلية والنفسية والبدنية وعلاقاته الاجتماعية لأمرين جوهريين؛ هما: الوراثة والبيئة. فالوراثة لا نملك أي خيار حيال ما ورثناه عن أسلافنا، لكن نملك الكثير مما يمكن فعله تجاه البيئة. وهنا يطرح سؤال عن مواصفات البيئة التربوية الجيدة. فعلى الرغم من التحديات الكونية التي تواجه الفتيان والفتيات، فإنهم يظلون أميل إلى الثقة بذويهم ومعلميهم – بوصفهم مرشدين ومعلمين- أكثر من ثقتهم فيمن لا يعرفون. وعلى هذا فلو نجحنا في تحسين مستوى الحيوية والتفاعل في مدارسنا وجامعاتنا؛ فإنَّ كثيرا من الأبناء سوف يتخذون من توجيهات معلميهم ومرشديهم نظارات يرون من خلالها العالم. وإن من حق الطالب أن يلمس في مدرسته الالتزام الأخلاقي والمروءة والحيوية والجدية والتعاون والنظام والنظافة. ونحن بحاجة إلى تطوير بيئة التعليم والارتقاء بها؛ لأن ذلك ارتقاء بمدلولات الكلمات التي نكوِّن من خلالها- ويكوِّن أبناؤنا كذلك- المفهومات والمشاعر ورؤية الماضي والمستقبل. ولا يغيب عن أذهاننا أن المدرسة أو النظام التعليمي هو جزء أو نظام فرعي من بيئة عامة شكلتها مجموعة النظم العقدية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة. ولهذا، فعلينا أن نستلهم الرؤية الإسلامية في الإصلاح، حيث يتم التركيز على الشمول في التعبير لكل نظم الحياة. وعلى سريان عقيدة العبودية- لله تعالى-، ورجاء الآخرة في كل الأنشطة التي يمارسها المسلم في أنشطته اليومية.
ثم يتحدث المؤلف عن البيئة التعليمية الجيدة؛ فالمدارس والمعاهد والجامعات بيئات تربوية متخصصة مختارة، ويرتجى منها في الأصل أن تقوم بوظائف تربوية؛ لا تستطيع الأسر القيام بها. وقد أوجز المؤلف أهم السمات التي تجعل من البيئة التربوية بيئة جيدة على النحو الآتي:
- التزام المؤسسة التعليمية بالمبادئ.
- تقويم الطالب على نحو صحيح، دون تزيّد في السلبيات أو تقليل من الإيجابيات.
- حتى تكون المدرسة بيئة إيجابية؛ فإن عليها أن تحفز روح الانفتاح والمصارحة والمشاركة والتعاون لدى جميع المنتسبين إليها.
- لن تصبح المدرسة بيئة إيجابية ما لم يتدرب إداريوها ومعلِّموها على حسن الإصغاء.
- نريد أن يسهم الطلاب أنفسهم في بلورة ما يمكن أن يلتزموا به في سلوكهم داخل المدرسة وخارجها؛ لا أن يملى ذلك إملاء عليهم، فهذا هو الطريق إلى تجذير الفضيلة والخير في نفوسهم.
- يكرَّم الطالب ويقدَّم بناء على صلاحه، وجهده واجتهاده، وليس لأسباب أخرى.
- لابد من المحافظة على مشاعر الاستقلالية والحرية” المنضبطة” لدى الطلاب.
- لا بد من انفتاح البيئة التعليمية على الآخرين من المفكرين والعلماء، لأن الانغلاق يسهم في إفسادها وإضعافها.
- تنظيم العلاقة بين المعلم والطالب على المستوى الأدبي، لكي تنجح المدرسة في أداء دورها كبيئة تربوية.
بناء العقل
كثر الحديث في القرآن الكريم والسنة النبوية عن التدبر والتفكر، واستخدام الطاقة الذهنية للإنسان في كل شؤون الحياة. والعلة التي يعاني منها الأجيال عندنا أن أبناءنا لم يعطوا أهمية أكبر للتفكير واستخدام الإمكانات الذهنية في تعليل الأحداث، وتحليل المعلومات وتوظيفها. وهذا جعلهم أقل من غيرهم مما هو موجود لدى أبناء الأمم المتقدمة. فمعظم المدارس والجامعات العربية والإسلامية خالية من أي مواد دراسية تعلِّم الأولاد كيف يتخلصون من الأخطاء الفكرية، وكيف يفكرون بطريقة صحيحة!
ومن القضايا المهمة التي طرحها المؤلف بشأن بناء العقل لدى الجيل المسلم، ما يلي:
- تنمية العقل أولًا: بتخليص عقول الناشئة من طرق التفكير المغلوطة، والأفكار المشوهة: كالمبالغة، والتحيز، والتعصب، والخضوع للعاطفة، والوقوع تحت تأثير الشائعات، والرؤية النصفية، وتفسير الظواهر الكبرى بعامل واحد، وما شابه ذلك.
- التفكير أثناء القراءة: ويكون بإثارة اهتمام الطلاب بقضية التفكير وتعويدهم عليها، من خلال إفساح وقت لممارسة التفكير. وعدم الاقتصار على القراءة والسماع دون التفكير فيما نقرأ ونسمع.
- اكتشاف نقطة التفوق: الذين نبغوا في العالم، كان بسبب اهتمامهم العظيم والبالغ بالجانب المبدع لديهم. وهكذا يجب أن نوجه طلابنا ونعرفهم بالمجال الذي يملكون فيه قدرات متميزة.
- صحة التصورات: من المهم أن نثري خبرات طلابنا حول فحص تصوراتهم، وحول المداخل التي يختارونها في معالجة مشكلة من المشكلات، وزيادة وعيهم بالأفكار التي يحملونها.
- مناخ الإبداع: نحن بحاجة إلى الاهتمام بالقيم العقلية كالذكاء والإبداع والفهم العميق، كما نهتم بالقيم الأخلاقية، لتحقيق آمال الامة وأهدافها، وحل مشكلاتها الكثيرة التي تعترضها، ولا يمكن أن يكون ذلك من غير الإبداع. ومناخ الإبداع الذي يجب أن نهيئه لطلابنا يتحقق بشرطين: الأمن، والحرية المنضبطة بضوابط الشرع.
وقد أوجز المؤلف أهم السمات التي تجعل من البيئة التربوية بيئة جديدة وجيدة.
جيل يعرف
إن العلم هو المصدر الأعظم لتكوين العقل، وتشكيل أسلوب حياتنا وعلاقاتنا؛ ولهذا، فإن تحسين مستوى المعرفة والتثقيف لدى الجيل المسلم الجديد- يجب أن يستحوذ على الكثير من اهتماماتنا وجهودنا. ومن الأفكار التي ساقها المؤلف لإبراز الملامح العامة للتثقيف الجيِّد لجيل المستقبل:
- الاهتمام بالقراءة.
- تعليم القراءة في وقت مبكر.
- بناء الخيال العلمي للأطفال في سن مبكرة.
- الاهتمام بالتخصص وتوجيه الطلاب إلى ذلك.
- تقديم المعلومات للطلاب في إطار من الحوار والنقد والترجيح والتحليل والتعليل.
- اكتشاف السنن، وتعميق معرفة الطلاب بقوانين الوجود.
- تكوين القارئ المعاصر (القارئ الجيِّد والنَّهم)، بتمليكه مهارات القراءة الجيدة.
- حتى لا يشوِّه التعليم العقل؛ علينا أن نراجع أسلوبنا في التثقيف العام، وفي التعليم المدرسي أيضًا.
شخصية المعلم
دور المعلم في التعليم هو الدور الأساسي، ومن غير النهوض به لا يمكن الحديث عن أي تقدم في التعليم؛ مهما أنفق عليه من مال، وهُيئ له من أسباب. وقد أوجز المؤلف ما ينبغي أن يتحلى به المعلم من سمات، وما يحمله من ثقافة، بالإضافة إلى المهمات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه:
- ثقافة المعلم: المعلم بحاجة إلى المعرفة الواسعة من أجل إثبات وجوده وتحقيق ذاته.
- المعلم القدوة: انسجام المعلم مع طبيعة المعرفة التي يقدمها، ومع طبيعة المهمة العظيمة التي ندب نفسه إليها- يعد شرطًا لا غنى عنه لنجاحه في عمله.
- المعلم مربٍّ: كما تفرض طبيعة التعليم على المعلم أن يكون قدوة؛ تفرض عليه كذلك أن يكون مربيًا.
- المعلم مجدِّد معرفة: تظهر براعة المعلمين الأكفَاء في شرح المعارف القديمة بعبارات جديدة، تلائم الذائقة الثقافية الجديدة.
- أنماط المعلمين: هناك المعلم الناجح الذي يؤدي عمله على أفضل وجه ممكن، وينتزع إعجاب طلابه به. وهناك أصناف أخرى من المعلمين؛ يجب العمل على رفع مستوياتهم ومساعدتهم على تجاوز النقاط السلبية في أدائهم؛ ويقع عبء ذلك على إدارة المدرسة، وباقي زملائهم: كالمعلم المهمل، والمعلم المستبد، والمعلم الفوضوي. أما المعلم العادي، فيجدر بالإدارة أن تنبهه إلى تنمية قدراته وتطوير نفسه.
المعلم بين الحقوق والواجبات:
يضيف المؤلف عددًا من العناصر التي تتعلق بهذا الجانب؛ من ذلك:
- اتهامات متبادلة: حيث يشكو الآباء من أداء المعلم، ويشكو المعلم من تقصير البيوت في القيام بواجبهم التربوي.
- الفجوة بين الممكن والمطلوب: سوف تستمر شكوى المعلم من أهالي الطلاب، وتستمر شكوى الأهالي من أداء المدارس، وعلاج ذلك يتمثل في الاستمرار في تحسين الأداء التربوي في البيوت والمدارس، من خلال الجهود الذاتية، والتعاون بين الآباء والمعلمين.
- حقوق المعلم من نوع مختلف: وهنا نتحدث عن الجانب المعنوي بشكل أساسي من التعبير عن الشكر والعرفان للمعلمين أولًا، ثم توفير بيئة تمكنه من القيام بعمله على نحو جيد.
- مزيد من العطاء: في مقابل اهتمام المجتمع بالمعلم؛ فإن على المعلم كذلك أن يهتم أكثر فأكثر بمهمته.
علاقة المعلم بالطالب
يوضح المؤلف أن المعلم المسلم مطالب بأن يجسد في علاقته مع طلابه القيم والمبادئ التي يؤمن بها، والدور الذي يقوم به مع طلابه في تشكيل عقلية الطالب ومشاعره، ورؤيته للحياة والأحياء. ثم يتحدث عن الآتي:
- معلم يزرع الثقة: نحتاج إلى المعلم الذي يزرع ثقة الطالب بأهليته للنجاح، وأهليته للتلاؤم مع البيئة الجديدة.
- هيبة المعلم: من المهم أن يشعر الطلاب بأن لدى المعلم أشياء كثيرة؛ الطالب في حاجة إليها، والشعور بتفوق المعلم خلقيًا وسلوكيًا.
- جو الاحترام: الاحترام الحقيقي الذي يتلقاه المعلم من طلابه يجب أن يكون صادرًا عن حبهم له وإعجابهم به.
- الاحتساب في التعليم: كانت فكرة الاحتساب وطلب المثوبة من الله تعالى على التعليم تسيطر على حسِّ الكثيرين من المعلمين المسلمين في الماضي؛ ولهذا كان العلم أحد أهم الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية.
- العلاقة التفاعلية: فالمعلم الجيد يقيم علاقة تفاعلية مع الطلاب.
- مشكلات التقويم: من المهم أن نبحث عن الأسلوب الذي يجعل من الامتحانات وسيلة لتنمية الطالب.
أسلوب التعليم
من المهم البحث دائمًا عن الأساليب الأكثر أناقة، والأكثر رقيًا في خطاب المربين للمتربين أو المعلمين للطلاب:
- التوسط في التعامل مع الناشئة: الطالب في حاجة إلى ألا نتخلى عنه وألا نهمله، كما أنه بحاجة إلى تكوين شخصيته ووجودها، والتوازن المنشود هو المطلوب.
- المعارف المقفلة: نهتم بتحفيظ الصغار القرآن الكريم وبعض المتون، كما كان القدماء يفعلون، وهذا جيِّد، كن إلى جانب هذا لا بد من تدريسهم بعض مهارات التفكير، ومحاولة تفتيح أذهانهم؛ لتكوين عقلية الطلاب التكوين الصحيح.
- الوضوح في الشرح: على المعلمين أن يسلكوا مختلف الطرق من أجل إيصال المعلومة التي يريدونها بالطريقة التي يستوعب بها الطلاب، ويتأكد المعلم من ذلك، ويراوح بين طرائق الشرح.
- التعليم التطبيقي: ربما كان من العيوب الكبرى التي يشكو منها التعليم في العالم النامي أنه يفتقر إلى التطبيق العملي، مما يجعل كفاءته محدودة وثمراته قليلة.
- السرد القصصي: المعلم البارع يستطيع من خلال مهارات السرد القصصي أن يثير الحيوية في أحداث بعيدة عن أذهان الطلاب في زمانها ومكانها، فتتحول إلى أدوات لزرع الأفكار فيهم، وإثارة المشاعر والأحاسيس النبيلة.
- تخفيف الضغوط: على المعلم أن يسعى إلى تخفيض درجة التوتر وإثارة والمقاومة للتعليم لدى الطلاب على مقدار ما يستطيع.
- التهديد واستخدام السلطة: الضغوط النفسية التي يولدها الضرب والتهديد والسخرية والنبز بالألقاب – تترك في عقل الطالب ونفسه آثارًا سيئة، قد تدمر حياته التعليمية كلها. وعلى ذلك فعلى المعلم ألا يلجأ إلى هذه الوسائل؛ فهي تقطع الطريق على إقامة علاقة حميمية بينه وبين الطلاب.
ثلاثة تحديات أساسية
ركز المؤلف على ثلاثة تحديات أساسية تعاني منها التربية في البيوت والمدارس؛ من ذلك:
- حضارة غير مواتية: يستعرض المؤلف انعكاس الآثار السلبية للحضارة الغربية على الأجيال المسلمة في مجالي: العلمي المعرفي، والمجال الاقتصادي المعيشي.
- وسائل تثقيف منافسة: أشار المؤلف إلى مزاحمة وسائل الإعلام بكافة أشكالها للمدارس في أداء دورها التربوي و التثقيفي والتعليمي.
- القصور الذاتي: يبين المؤلف أن الكثير من المشكلات الجوهرية التي تعاني منها مدارسنا؛ ليس من أسباب خارجية، وإنما من ارتباكها حيال نظمها ومشكلاتها الخاصة.
آفاق التجديد التربوي
يقدم المؤلف بعض التوصيات التي تساعد في التجديد التربوي:
- إن ما يحتاج إليه النهوض بالتعليم يستدعي التزامًا دائمًا بالتطوير والتغيير.
- تشكيل مجالس نوعية من الأهالي والمتخصصين، لتوسيع دائرة المهتمين بأعمال المدرسة ومشكلاتها، ودعم إدارات المدارس وتذليل العقبات التي تواجهها.
- يجب إنشاء مدارس نموذجية تتعلم منها المدارس الأخرى، تتمتع بإدارة حديثة جيدة، ومعلمين صالحين أكفاء، وطلاب جادين.
- الاستفادة من وسائل الإعلام بكل أنواعها في تعميم الأفكار التربوية.
- الاهتمام بتكوين الشخصية المسلمة.
- يجب ألا يكون المال حائلًا دون التحديد والتطوير في المدارس.
- لا بد من تشكيل نظرة كلية لدى الطالب تمكنه من فهم عميق لأوضاع عصره.
- يجب أن تعِين المدارس الآباء والأمهات على القيام بواجباتهم التربوية.
- على المدارس والجامعات أن تهتم برفع مهارات الطالب وتدريبه، ليمتلك المؤهلات التي تناسب سوق العمل.
من ثمرات الكتاب وفوائده
- ترجع أهمية الارتقاء بالتربية والتعليم في مؤسساتنا التعليمية إلى فهم الإسلام والتفاعل معه في كل قضايانا، والتقدم العلمي.
- عدم وضوح الهدف من التربية لدى القائم بالعملية التعليمية يؤدي إلى عدم تناسق الجهود التربوية وتصادمها.
- يمكن تلخيص المقومات التي يجدر بالمربين والمعلمين تحقيقها في الأجيال الذين نستهدفهم بالتكوين وفق منهج التربية الإسلامية – في ستة محاور: المحور الإيماني والتعبدي، والمحور الأخلاقي والسلوكي، ومحور الانتماء، ومحور الذات، والمحور التدريبي، والمحور المعرفي والعلمي.
- يجب تحسين مستوى الحيوية والتفاعل مع طلابنا في البيئات التربوية والتعليمية.
- العلة التي يعاني منها الأجيال عندنا أن أبناءنا لم يعطوا أهمية أكبر للتفكير واستخدام الإمكانات الذهنية لديهم في تحليل الأحداث، وتشكيل أسلوب حياتنا وعلاقاتنا.
- من غير النهوض بالمعلم لا يمكن الحديث عن أي تقدم في التعليم.
- المعلم المسلم مطالب أن يجسِّد في علاقته مع طلابه القيم والمبادئ التي يؤمن بها، وتشكيل عقلية الطالب ومشاعره، ورؤيته للحياة والأحياء.
- من التحديات التي تعاني منها التربية في البيوت والمدارس – سلبيات الحضارة الغربية التي غزتنا، والتثقيف المنافس، والمشكلات الداخلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.