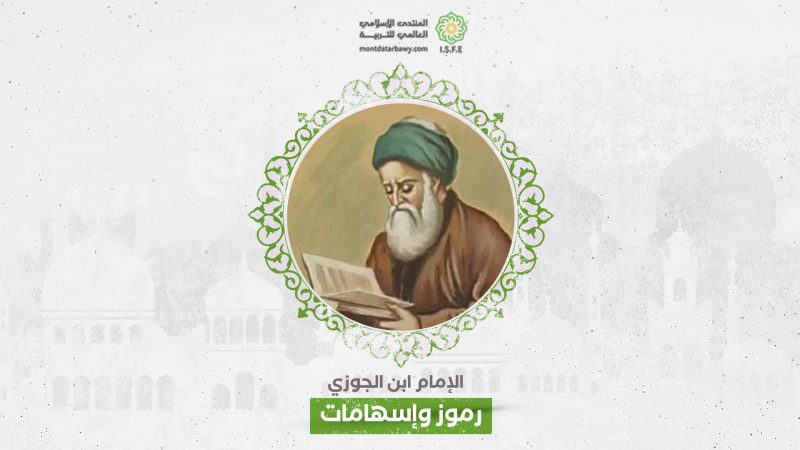جاءت اجتهادات الإمام ابن الجوزي التربوية لتبرز إلى جانب اجتهادات أقرانه من رجالات الفكر الإسلامي، معالم صورة رائعة لنتاج الثقافة الإسلامية في مجال التربية، بل كانت تشكل نظامًا تربويًّا متكامل البنيان راسخ الأصول.
ولقد فصّل الإمام “أبو فرج” تجربته في التربية الذّاتية من خلال كتابه “لفتة الكبد في نصيحة الولد” الذي يُعدّ رسالة أبوية من أب لابنه، يحثه فيها على طلب العلم وامتثال أوامر الله والانتهاء عن نواهيه، وقد قال في سبب تأليفه: “ثم رأيت منه توان عن الجد في طلب العلم، فكتبت له هذه الرسالة، أحثُّه بها على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق- سبحانه وتعالى- مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق، ولا مرشد لمن أضل”.
من هو الإمام ابن الجوزي؟
والإمام ابن الجوزي هو أبو الفرج، جمال الدين، عبد الرحمن الجوزي القرشي التميمي البكري من بني محمد بن أبي بكر الصديق، ولد سنة 509 هـ، أو 510هـ، ثم ترعرع على حب الوعظ والعمل به، وتوفي والده وله ثلاثة أعوام، فربته عمته، وأقاربه كانوا تجارا في النحاس.
وكان وهو صبي ديّنًا، ولا يأكل ما فيه شبهة، ولا يخرج من بيته إلا للصلاة، وكان لا يلعب مع الصبيان، ذا همة عالية، ولقد ظل طوال حياته يطلب العلم ويعظ ويصنف، وتعلم الكثير من شيوخ عصره، منهم ابن ناصر في علم الحديث، وسبط الخياط في القرآن والأدب، ومن تلاميذه ابنه العلامة محيي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بالله، وولده الكبير علي الناسخ، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف، صاحب “مرآة الزمان”.
وتفرّد أبو الفرج، في الوعظ والتربية، حتى قال عنه الحافظ الذهبي: “كان رأسًا في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديهًا، ويُسهب، ويُعجب، ويُطرب، ويُطنب، لم يأتِ قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه، مع الشكل الحسن، والصوت الطيب، والوَقع في النفوس، وحسن السيرة”.
وظل أبو الفرج يعمل بجد واجتهاد في حقل الوعظ وتربية الأجيال، حتى تُوفّي ليلة الجمعة 12 رمضان سنة 597 هـ، ببغداد، ودفن بباب حرب.
ابن الجوزي ومجالات التربية الذاتية
وتميزت المجالات التي يجب الاعتناء بها في تربية الذات لدى الإمام ابن الجوزي بوضوح المعالم، وشمولية التربية، وتركيز الهدف، وصرامة قيادة الذات لاستكمالها، وهي تشمل ما قاله لابنه كالتالي:
- التربية على التقوى والإخلاص، يقول: “وها أنا قد ترى ما آلت حالي إليه وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة، وهي قوله تعالى: {وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ}”.
ويقول: “يا بني، ومتى صحت التقوى رأيت كل خير، والمتقي لا يرائي الخلق، ولا يتعرض لما يؤذي دينه، ومن حفظ حدود الله حفظه الله.. واعلم أن أوفى الذخائر غضُ الطرف عن محرَّمٍ، وإمساكُ اللسان عن فضول كلمة، ومراعاةُ حدٍّ، وإيثارُ اللهِ سبحانه وتعالى على هوى النفس”. ويقول: “فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن لقمة إلا بنية”. - التربية على الاستعداد للآخرة، يقول: “فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا، فرضنا ستين سنة مثلاً، فإنه يمضي منها ثلاثين سنة في النوم، ونحوًا من خمس عشرة في الصبا، فإذا حسب الباقي كان أكثر في الشهوات والمطاعم والمكاسب- فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرًا، فبماذا تشتري الحياة الأبدية، وإنما الثمن هذه الساعات؟”.
- التربية على العبادات، ويقول: “واعلم أنّ أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار النار”.
- التربية على الآداب، منها العزلة عن أصحاب السوء، فيقول: “وعليك بالعزلة، فهي أصل كل خير، واحذر من جليس السوء”، ومنها الزهد في الدنيا، فيقول: “واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها، واقنع تعز…”، ومنها القيام بالحقوق، فيقول: “وأدِّ إلى كل ذي حق حقه من زوجة وولد وقرابة”، ومنها تأديب النفس، فيقول: “وراع عواقب الأمور، ليهن عليك الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره…”.
- التربية على طلب الكمال، يقول: “وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلقًا وقفوا مع الزهد، وخلقًا تشاغلوا بالعلم، وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل”.
- التربية على الجمع بين العلم والعمل، يقول في الجمع بينهما: “وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع به”، ويقول: “وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، فإن خلقًا كثيرًا من المتزهدين المتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم”.
ويقول: “ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الحجر”، ويقول: “وعلى الحقيقة، فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصلا رَفَعَا صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق – سبحانه وتعالى – وحرّكاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه”.
ويقول في التربية العلمية: “وأول ما ينبغي النظر فيه: معرفة الله تعالى بالدليل… ثم يتأمل صدق الرسول- صلى الله عليه وسلم إليه-، وأكبر الدلائل: القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله… ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الواجبات، فإذا عرف قدر الواجب قام به… ولا بُد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو، ومعرفة طرف مستعمل من اللغة… والفقه أصل العلوم”.
أساليب التربية الذاتية
وحدّد الإمام ابن الجوزي هدفه في استكمال تربية الذات في المجالات السابقة، وقد تميزت بالتنوع، والشمول، والصرامة في تطبيقها، وهي تشمل:
1) الاشتغال بطلب العلم الشرعي: ويشمل:
- حفظ القرآن والسنة، يقول: “… فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره، وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم…”.
- حفظ وكتابة دروس العلماء ومراجعتها، يقول: “… بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير، فأحفظ جميع ما أسمعه، وأذهب إلى البيت فأكتبه”، ويقول: ” ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر، آخذ جزءاً، وأقعد حُجْزَة من الناس إلى جانب الرَّقة، فأتشاغل بالعلم”، ويقول: “فعليك بالحفظ، وإنما الحفظ رأس المال”.
- التوسع في طلب العلم، يقول: ” ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث…”.
- ملازمة العلماء ومسابقة الطلاب إليهم، يقول: “ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل أبي ناصر وكان يحملني إلى الشيوخ، فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها، ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل”، ويقول: “ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، فينقطع نفسي من العدو لئلا اُسْبق”.
- حضور مجالس العلماء الزائرين لبلده، يقول: “ولم أترك أحداً ممن يروي ويعظ، ولا غريباً يقدم إلا وأحضره”.
- إحكام العلم، يقول: “ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله”.
- النفقة في طلب العلم، يقول: “واعلم يا بني أن أبي كان موسراً، وخلّف ألوفاً من المال، فلما بلغت دفعوا لي عشرين ديناراً ودارين، وقالوا لي: هذه التركة كلها، فأخذت الدنانير واشتريت بها كتباً من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم…”.
2) التبكير في التربية:
يقول: “فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن ست سنين، وأنا قرين الصبيان الكبار- قد رقت عقلاً وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكاً خارجاً، حتى إني كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع…”.
3) الاجتهاد في طلب الكمال، يقول: “… وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل ما يُراد مراداً، ولا كل طالب واجداً، ولكن على العبد الاجتهاد…”، ويقول: “ولم أقنع بفن من العلوم”.
4) رفع الهمة وتخليص النفس من الكسل، يقول: “والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه واتعب لنفسك”، ويقول: “وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حُثّت سارت، ومتى رأيت في نفسك عجزاً فسل المنعم، أو كسلاً فالجأ إلى الموفق”، ويقول: “وألزمت نفسي الصبر فاستمرت، وشمرت ولازمت، وعالجت السهر”.
5) تزكية النفس بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، يقول: “فلن تنال خيراً إلا بطاعته، ولا يفوتك خيرٌ إلا بمعصيته…”، ويقول: “فالزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر ولا تتحدث بحديث الدنيا… وقل ذكر الاستيقاظ من النوم… ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر، واخرج إلى المسجد خاشعاً… واقصد الصلاة إلى يمين الإمام… ثم عليك بالأذكار بعد الصلاة… فإن صح لك فاجلس ذاكراً الله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ثم صلِّ واركع ما كتب لك، وإن كان ثماني ركعات فهو حسن”.
6) المداومة على مطالعة سير السلف، يقول: “ينبغي التشاغل بمعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه والعلماء بعدهم، ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى…”، ويقول: “وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف… وتَلَمَّح سير الكاملين في العلم والعمل”، ويقول: “ومع مطالعة أخلاق السلف ينكشف لك الأمر”.
7) استغلال الوقت وتنظيمه، يقول: “فانتبه يا بني لنفسك… واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، واسق غصنك ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة…”، ويقول: “واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسًا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نَفَس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم”.
هكذا، نجد المنهج التربوي لدى الإمام ابن الجوزي المُفكّر والفقيه والواعظ والأديب، الذي نهل من الثقافة الإسلامية وارتشف من ثقافات عصره المختلفة وخرج من ذلك بآراء وحلول تستند على أُسس إسلامية أصيلة لم تصطدم مع واقع عصره، وفي الوقت نفسه كانت حلقة من سلسلة التراث الإسلامي.
المصادر والمراجع:
- الدكتور حسن إبراهيم عبد العال: من ملامح الفكر التربوي عند الإمام أبي الفرج بن الجوزي، . مجلة رسالة الخليج العربي – الرياض، ص 22.
- أبو شامة المقدسي: ذيل الروضتين، ص 21.
- ابن كثير: البداية والنهاية، 13/28.
- الذهبي: سير أعلام النبلاء، 21/366.
- فكرت إبراهيم أحمد عوض: الفكر التربوي عند الإمام ابن الجوزي، ص 104.