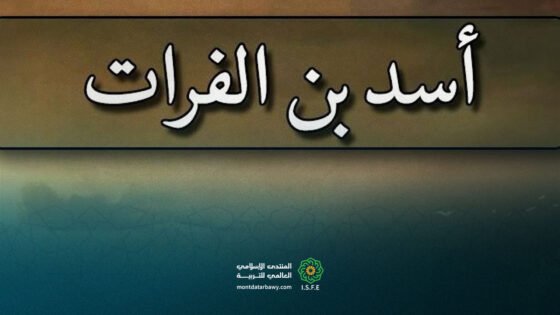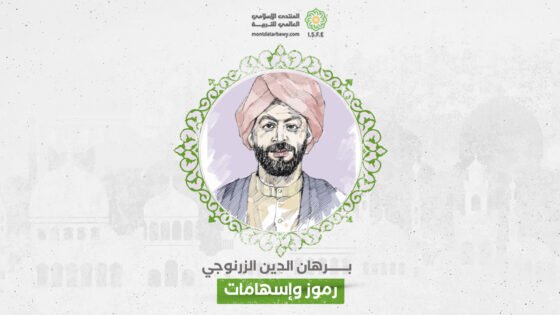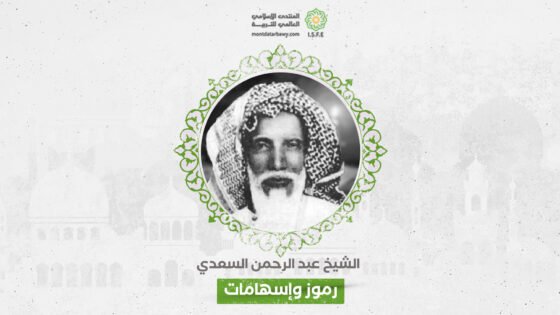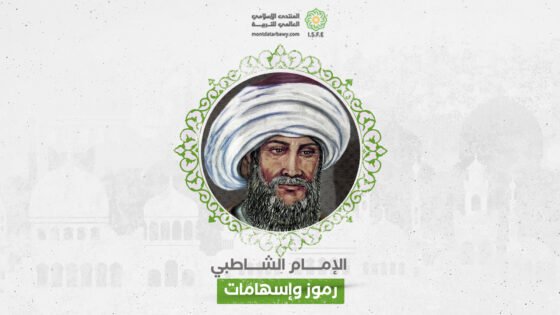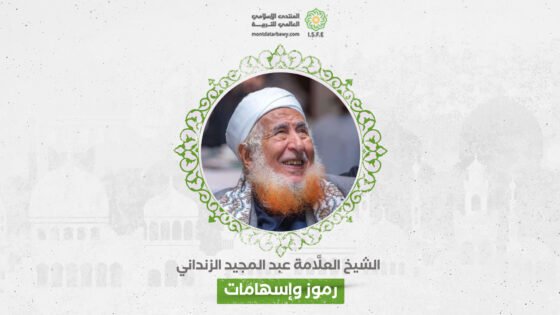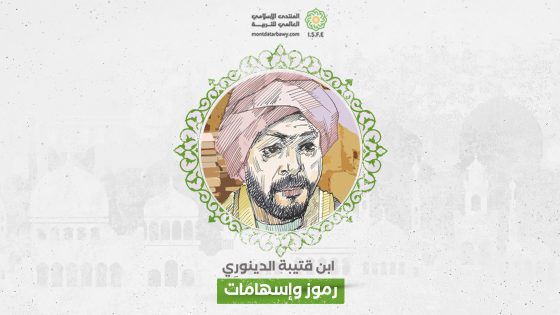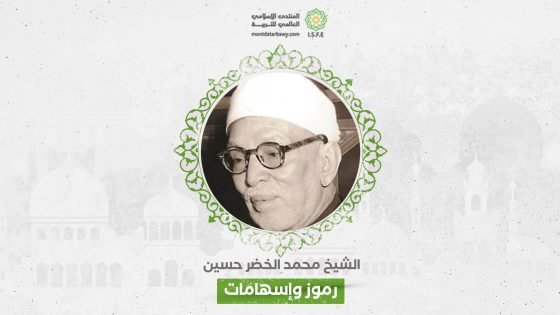زخرت الجزائر بمصلحين وعلماء تركوا فيها وفي المجتمعات الإسلامية بصمات وأطرًا تربوية فكرية لا يغفل عنها ولا يتجاهلها أحد، ومنهم العلامة عبد الحميد بن باديس الذي واجه المحتل الفرنسي وكان حائط صد لعمليات طمس الهوية الإسلامية الجزائرية، وترك فكرا تربويا متشعبا في العديد من الجوانب الفكرية والتربوية، تتلمذ عليها الكثير من مفكري ومصلحي هذه الأمة.
وليس تناول حياة الرجال العظماء الذين رسخوا قواعد دعوة الإسلام المعاصرة نوعا من الحكايات والتسلية فقط، بل إن مراجعة تلك الحيوات والتصرفات هي مادة للتأمل، والتعلم، والاعتزاز بهؤلاء الرجال الذين حملوا الأمانة في وقت كانت ترزح فيه البلاد تحت نير الاستعمار.
صمام أمان
خلق الله سبحانه الكون بنظام دقيق، وكما وضع الله لهذا الكون قوانينه، وضع للإنسان قوانين تحكم سيره وحركته، وأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين ومبلغين ومعرفين حقيقة الحياة ومعنى العبودية لله الواحد.
وبعدما ختم الله الرسل برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ساق الله للأمة علماء ومصلحين يعرفونهم حقيقة الحياة والتمسك بشئون دينهم ومدى العزة والقوة في تمسكهم بها، وعواقب الحيد عن شرع الله فقال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} [هود: 117].
من ابن باديس؟
ولد عبد الحميد بن محمد بن مكي بن باديس في مدينة قسنطينة إحدى مُدن الجزائر، في 2 ديسمبر 1889م، وسط أسرة اهتمت بالعلم وحرصت على شرائع الدين.
ينحدر من أسرة ذات شرف وجاه مما أغناه مؤونة العيش أو الاعتماد على الوظائف التي كان يسيطر عليها المحتل الفرنسي بالجزائر، وقد ساعده ذلك على التفرغ للعلم، وإلى إحياء روح النهضة والكفاح البطولي عند الشعب الجزائري، ودعم ثورته ضد المحتل الفرنسي.
تتلمذ على يد الشيخ محمد النخلي، والشيخ الطاهر بن عاشور بجامع الزيتونة بتونس، وسافر عام 1913م للحجاز فنال الحج ونال العلم على أيدي علمائها، وتعرف فيها في هذه الفترة على العلامة محمد البشير الإبراهيمي، وذلك قبل أن ينتقل إلى سوريا ولبنان ومصر لينهل من العلوم ويكون رأيًا عامًا للقضية الجزائرية.
وحينما عاد للجزائر كان في طليعة المطالبين بحرية وطنهم وأخذ مع ذلك بشتى الوسائل حيث اهتم بالتعليم، وتثقيف الرأي العام الجزائري عن طريق إصدار الصحف، وأكد على أهمية مشاركة العلماء في العمل السياسي وواجه من انتقده في ذلك، وأكد على أن المسلمين لم يتأخروا عن ركب الحضارة إلا لأنّهم أقصوا العلماء عن سدة الحكم. واجه المستعمر الفرنسي واضطهاده وظل كذلك حتى رحل في 16 أبريل 1940م، حيث احتشدت الجماهير لتوديعه(1).
مساره التعليمي والإصلاحي
يعتبر ابن باديس أحد أئمة الإصلاح والتغيير وشيوخ الحصانة الثقافية في العالم الإسلامي، ولقد استشعر أهمية البناء التعليمي من رحلاته العلمية التي زار فيها الحجاز وسوريا ومصر، وهو ما يلخصه في قوله: (العلم هو وحده الإمام المتبع في الحياة في الأقوال والأفعال والاعتقادات)(2).
وهو ما دفعه للعناية بالتربية العلمية والفكرية وتثقيف الوعي الجزائري لمجابهة طمس الهوية التي يقوم بها المحتل الفرنسي، ونشر الجهل والفقر، وأن سلوك الإنسان مرتبط بتفكيره، فيقول: (سلوك الإنسان في الحياة مرتبط بتفكيره ارتباطاً وثيقاً، يستقيم باستقامته ويعوج باعوجاجه ويعقم بعقمه. لأن أفعاله ناشئة عن اعتقاداته، وأقواله إعراب عن تلك الاعتقادات، واعتقاداته ثمرة إدراكه الحاصل عن تفكيره ونظره)(3).
يقول الدكتور علي الصلابي: (هكذا قرر ابن باديس – رحمه الله – بأن الاكتشافات العلمية التي نقلت الإنسان من طور إلى طور، وغيرت مجرى حياته تغييرًا كليًا، إنما هي نتيجة إعمال الفكر الذي هو ثمرة العلم.. وهدف الشيخ ابن باديس من وراء الدعوة إلى تعلم اللغات الأجنبية، إنما هو التمكن من العلوم والتكنولوجيا، فما دام مصدر العلم هو أوروبا، فبات من المصلحة الحرص على تعلم هذه اللغات)(4).
ومن هذا المنطلق اهتم ابن باديس بالنهوض بالتعليم وإصلاحه ونشره بين الناس ليتسلحوا به أمام التغريب الغربي.
نظرته للمحتل
حاول البعض غمز العلامة ابن باديس بأنه كان على توافق مع المحتل لمنادته بتعلم اللغة الفرنسية، وأنه كان معجبا بأتاتورك، وهذا تحريف لقصد ابن باديس في دعوته لأهمية العلم وتعلم لغة الغرب للاستفادة من تقدمهم.
لقد استهدف ابن باديس إعادة إحياء هوية الإنسان الجزائري، ونادى بحرية وطنه والعمل على إخراج المحتل منه، وكان من مخرجات ذلك تكوينه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 5 مايو 1931 والتي كان لها دور كبير في تحرير الجزائر.
(لقد قاد ابن باديس إصلاحاً جزائرياً خالصا، تعامل مع الواقع الجزائري تحت الاستعمار الفرنسي، استهدف إعادة إحياء هويّة الإنسان الجزائري)(5). عن طريق العناية بالتعليم وتوعية الرأى العام ضد خطر المحتل.
مناجزة المستعمر
قبل ابن باديس (مبدئيا) بالحماية الفرنسية بشرط مساواة المواطنين الجزائريين مع المواطنين الفرنسيين في الحقوق والواجبات، والاعتراف بخصوصيتهم الثقافية والدينية.
وفي نفس الوقت اعتمد سياسة تثقيف المجتمع وتعليمهم اللغتين العربية والفرنسية من أجل تكوين جيل يستطيع أن يناجز المستعمر بلغته في المحافل الفرنسية والدولية والتي لم يكن يسمع للجزائريين أي صوت.
وهو ما نجح فيه ابن باديس خلال تاريخه النضالي، فقبوله مبدئيا للحماية حتى يخلق جيلًا يستطيع أن يفضح المحتل في عقر داره وفي المحافل الغربية(6).
ابن باديس ومفهوم الوطنية
احتلت فرنسا الجزائر عام 1830م وبقيت بها حتى عام 1962م، أي ما يزيد عن 130 عاما ظنت فيها فرنسا أن الجزائر أصبحت قطعة من فرنسا أو مقاطعة تابعة لها، خاصة مع سن القوانين التي تؤكد على هذا الأمر بين الحين والآخر.
غير أن ابن باديس يكاد يكون أول من حدد فكرة الوطن الجزائري في المنتصف الأول من القرن العشرين، حيث أصدر جريدة المنتقد عام 1926 وجع شعارها “الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء”، ووقف لسياسة فرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وكشف للجنود الذين وقفوا بجانب فرنسا في الحرب سياستها التي تكيل بمكيالين حيث نكلت بالجنود وأسرهم والجزائريين(7).
يقول ابن باديس: “الأمة الجزائرية أمة متكونة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا. ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال، ولها وحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها بما فيها من حسن وقبيح، شأن كل أمم الدنيا”.
ويضيف: “هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها، لا تريد أن تندمج، ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة والذي يشرف على إدارته العليا السيد الوالي العام المعين من قبل الدولة الفرنسوية”.
ويشدد: “نحب من يحب وطننا ويخدمه، ونبغض من يبغضه ويظلمه، فلهذا نبذل غاية الجهد في خدمة وطننا الجزائري وتحبيب بنيه فيه، ونخلص لكل من يخلص له، ونناوئ كل من يناوئه من بنيه وغير بنيه”.(8).
سياسة ابن باديس
لم يفرق ابن باديس بين الإسلام والعمل السياسي، واعتبر أن العلماء لابد لهم أن يخوضوا مجال السياسة، وأكد أن المسلمينَ لم يتأخروا عن ركب الحضارة إلّا لأنّهم أقصوا العلماء عن سدّة الحكم، خاصة أن الإسلام ترك للمسلمين شكل الحكم الذي ينظم شؤونهم وحياتهم ويحفظ سيادتهم.
وضع ابن باديس مبحثًا بعنوان (أصول الولاية في الإسلام) أوضح فيه أصول هذه الولاية وجاء فيها:
(لا حقَّ لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة، فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل، فلا يتولَّى أحد أمرها إلا برضاها، فلا يورث شيء من الولايات، ولا يستحقُّ الاعتبار الشخصي. وهذا الأصل مأخوذ من قوله: (وُلِّيت عليكم) أي: قد ولَّاني غيري، وهو أنتم)(9).
ووضع ابن باديس ثلاثة عشر أصلا استقاها من خطبة الخليفة أبو بكر الصديق يوم السقيفة، والتي وضحت رؤية الإسلام لنظام الحكم.
كما عمد ابن باديس إلى توضيح مكامن الخطر السياسي والاقتصادي والثقافي، وعمد لإعداد جيل قادر على المواجهة والتحدي، ومحاربة من كانوا يشوهون الإسلام، واهتم بالصحافة السياسية لتوعية الشعب، وقد طالب بقوله (لابد من تشريكنا تشريكا سياسيا واقتصاديا في إدارة شؤون وطننا الجزائري)(10).
كان واضحا من فكر ابن باديس أنه لم يفصل الجانب السياسي عن باقي جوانب الحياة، بل جعلها في قلب الجوانب التي يجب على المسلم الاهتمام والعناية بها، وهي التي دفعته لمقاومة سياسة الإدماج والتجنيس التي مارسها المحتل الفرنسي، حتى أنه أفتى بحرمة التجنيس تحريما قاطعا.
المصادر
- فهمي توفيق محمد مقبل: عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والنهضة في تاريخ الجزائر الحديث، الأردن: صـ 4- 30،
- ابن باديس: آثار ابن باديس، ت عمار طالبي، دار ومكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، الطبعة الأولى، 1997، صـ269.
- المرجع السابق.
- علي الصلابي: العلامة ابن باديس والبناء الفكري والتعليمي، 13 مايو 2015،
- أسامة ٱغي: البعد التحرري والتنويري في فكر عبد الحميد بن باديس،
- الشيخ أحمد البان: التكامل في فكر ابن باديس، 5 نوفمبر 2014،
- مسعود جباري: الفكر السياسي عند الشيخ عبدالحميد ابن باديس، رسالة ماجستير، كلية أصور الدين، جامعة الجزائر، 2001م.
- ابن باديس: آثار ابن باديس، مرجع سابق، صـ383، وانظر مجلة الشهاب الجزائرية: نوفمبر 1937م.
- ابن باديس: آثار ابن باديس، مرجع سابق، المجلد الرابع، صـ401، ولمزيد من الأصول طالع الدرر السنية:
- ابن باديس: آثار ابن باديس، مرجع سابق، المجلد الخامس، صـ174.