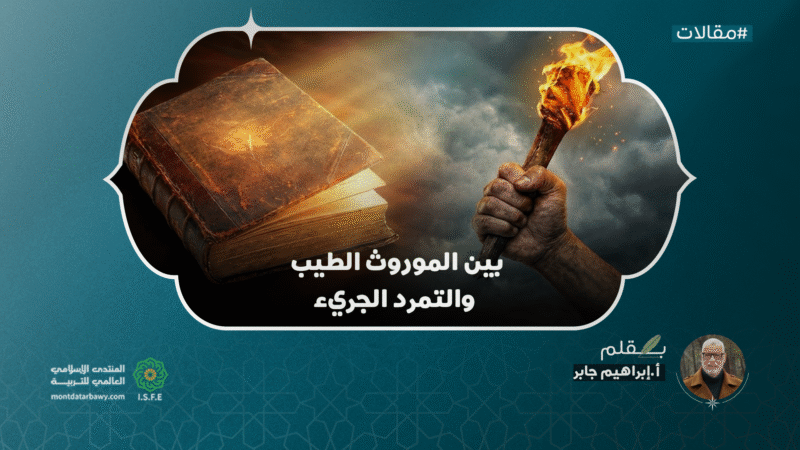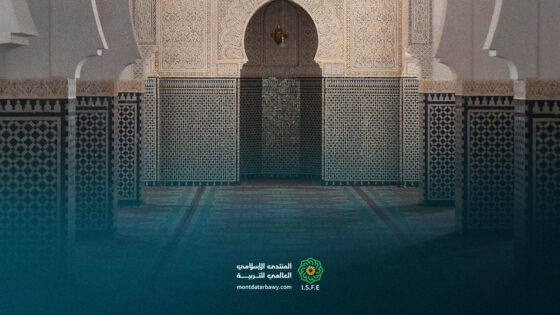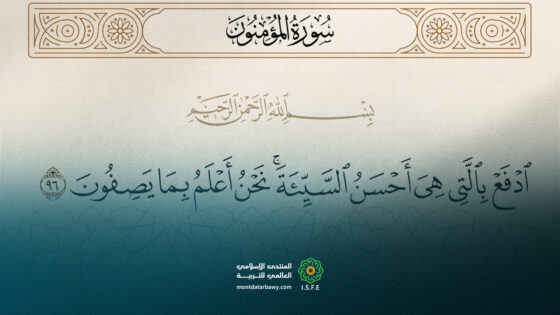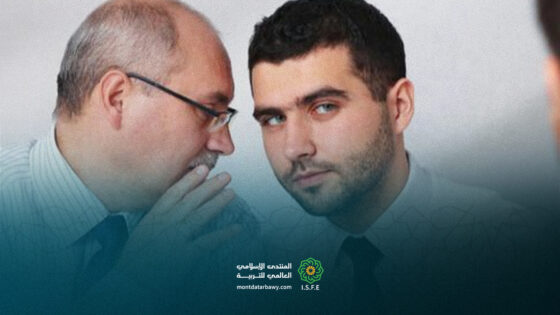بقلم: أ. إبراهيم جابر
حين اتّسعت سماء الفضائيات، لم يتّسع معها قلب المجتمع بالقدر نفسه؛ فخرجت الأفكار من عقالها، واصطدمت الأجيال كما تصطدم أمواجٌ لا تعرف وجهتها.
فجأة وجد الشباب أنفسهم أمام عالم بلا أسوار، عالم يُسمع فيه صوت الفيلسوف مثل صوت المهرج، ويجلس فيه المبدع بجوار الهادم، وتُقلب فيه المسلّمات كما تُقلب صفحات الهاتف، في زمنٍ أصبحت فيه الأصابع أسرع من العقول، والخواطر أقوى من الحجج، والبحث عن المختلف أشهى من الالتزام بالمعروف.
في هذا الضجيج نهض المفكرون وأصحاب الرأي، يحاول كل منهم أن يقدّم رؤية، أو يصلح عطبًا، أو ينقذ ما يمكن إنقاذه. لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة تيارين متوترين: شبابًا يتوثّبون لكسر كل قيد ولو كان حبل النجاة، ومحافظين يتمسكون بالمألوف حتى لو صار يابسًا لا يثمر.
كأنّ الفريقين وقف كل منهما على شاطئ، لا هذا يسمع ذاك، ولا ذاك يمد يده لهذا. وبينهما فجوة واسعة حفرها تراكم السنين وضعف التربية وضياع لغة الحوار.
الحقيقة أن المشكلة أعمق من قنواتٍ في السماء؛ إنها مشكلة تربيةٍ ضاعت فيها الجذور، وتربيةٍ لم تُجدّد فيها الأشجار أوراقها.
الشاب الذي لم يتذوق دفء القدوة في بيته، ولم يجد من يعلمه كيف يفكر قبل أن يعترض، وكيف يتأمل قبل أن يُنكر، وكيف يطلب الدليل دون أن يهدم الأصل — سيذهب إلى السوق الجديد بعطشٍ يلتقط معه كل شيء، نافعًا كان أو سامًا.
والكبير الذي لم يُدرَّب على الإصغاء، ولم يتعلم أن الزمان يتغيّر، وأن العقول لا تُقاد بالرهبة بل بالرحمة، سيظن أن كل جديد خيانة، وأن كل سؤال جريمة، وأن الدفاع عن الماضي أهم من صناعة المستقبل.
هذه اللحظات ليست جديدة على التاريخ؛ فقد عاشتها الأمة مرارًا. في بغداد يوم دخلت الفلسفة، وفي الأندلس يوم ظهرت الفنون، وفي مصر يوم هبّت رياح النهضة الأوروبية. دائمًا كان هناك شابٌ يتساءل، وشيخٌ يخشى، ومفكرٌ يحاول الجمع ولا يملك الأدوات، وتبقى الفجوة بين الأجيال لا ينقذها إلا مربٍ حكيم يعرف أن القلوب تُقاد بالطمأنينة لا بالصراخ، وبالبصيرة لا بالتخويف، وبالقدوة لا بالمحاضرات الطويلة.
وإن كانت هذه الفجوة تشقّ المجتمع بعمومه، فإنها لم تستثنِ حتى أولئك الذين اختاروا طريق الدعوة والإصلاح. بل ربما كانت أشدّ وطأة حين تدخل بيوت الحركة الإسلامية نفسها، حيث يُفترض أن تكون التربية أرسخ، والأواصر أمتن، والرؤية أوضح.
وكأنّي بشباب الحركة الإسلامية اليوم، قلوبهم معلّقة بالمستقبل، وأرواحهم تتململ مما لا يفهمونه، وأسئلتهم مثل شررٍ تحت الرماد: لماذا نفعل هذا؟ لماذا لا نغيّر ذاك؟ أين نذهب؟ وإلى أين تتجه دعوتنا؟ أسئلة مشروعة، صادقة، نابعة من حرارة العطاء، لا من سوء الأدب، لكنهم يخشون أن يطرحوا؛ خشية أن يُتَّهموا بالتهوّر أو قلّة الفهم أو «قلة الأدب التنظيمي».
وكأنّي بالكبار والرموز… تجاربهم دهور، وظهورهم مثقلة بسنين الابتلاء، يخشون أن تنزلق أفكار الجيل الناشئ من بين أصابعهم، وأن يطغى الجديد على القديم، وأن ينهدم ما بنوه حجرًا فوق حجر، فيميلون إلى التشديد، وإلى المحافظة، وكأنهم يقولون في سرّهم: “اخشَ أن تهدم ما لا تعرف ثمن بنائه.”
لكن، في وسط هذا كله… يوجد فريق ثالث، نادر، مبارك، فريق عرف حرارة الشباب، وذاق كذلك مرارة التجربة، فصارت بصيرته جسراً بين الضفتين، يصرخ في الفريقين: إن طرقكم واحدة، وإن اختلافكم وقود، لا لعنة. وإن السفينة لا تسير بلا شراع الشباب، ولا بلا ثقل الشيوخ الذي يمنعها من الانقلاب.
هكذا كان في دار الأرقم: شبابٌ صاعدون من مكة، ووجوهٌ من نخبة قريش، وساداتٌ وعبيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الجميع بلا أن يُسقط جيلًا لحساب جيل.
مصعب بن عمير شابّ غضّ، لكن أُرسل في أهم مهمة في الدعوة. وصهيب وبلال وخباب شبابٌ نظروا إلى السماء أكثر مما نظروا إلى الأرض. ومع ذلك… كان أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ يسندون المشروع بثبات الجبال.
وفي صفّين، والنهروان، وأيام عمر بن عبد العزيز… كان الصدام بين “التجديد” و”المحافظة” يتكرّر، لكن الدعوة تبقى ما دام في الأمة من يعرف كيف يُمسك يد الشاب بيد الشيخ ويقول لهما: أنتم لستم خصومًا… أنتم جناحان لطائر واحد.
التربية — لا الفضائيات ولا التنظيمات — هي التي تُصلح المسار. التربية التي تمنح الشاب مساحة يسأل فيها دون خوف، وتمنح الكبير قدرة يستمع بها دون أن يشعر بالهزيمة. التربية التي تُعطي كل جيلٍ حقه في البحث والاكتشاف، لكنها تُمسك بيده حتى لا يسقط في الهاوية.
المشكلة ليست في الأسئلة، ولا في خوف الشيوخ، ولا في اندفاع الشباب، بل في غياب المدرسة التي تعلّم الجميع آداب الحوار، وأدب الاختلاف، وأدب السير المشترك.
ذلك الفنّ الذي أتقنه النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل من طاقات الشباب قوة، ومن حِكمة الكبار ضابطًا، ومن الحوار منهجًا، فلا أحد يُقصى، ولا أحد يُقدَّس فوق النقد.
التربية التي تجعل الشاب يرى أن جذور تراثه حية وليست حجارة، وأن فكر المفكرين ضوء لا نار، وأن تجربة المحافظين درع لا قيد. التربية التي تعلّمنا أن التجديد إذا خرج من قلبٍ عامر باليقين صار قوة، وإذا خرج من قلب جائع للظهور صار فتنة.
تنهض الدعوة حين يجد الشاب شيخًا يسمعه، وحين يجد الشيخ شابًا يحترمه، وحين تصير الحركة خيمةً واسعة، يسكن تحتها الحماسُ والرصانة، الاندفاعُ والحكمة، السؤالُ والتجربة.
والحقيقة التي يجب أن تقال بلا تجميل: الجيلان يحتاجان إلى بعضهما أكثر مما يتصوران.
الشيوخ بلا شباب… يتحولون إلى ذكريات. والشباب بلا شيوخ… يتحولون إلى مغامرين بلا بوصلة.
ولن تنتهي هذه الإشكالية حتى نعيد صياغة علاقتنا ببعضنا: أن يصبح الكبير أبًا لا حارسًا، وأن يصبح الشاب تلميذًا مجتهدًا لا متمرّدًا، وأن يصبح صاحب الفكر جسرًا بينهما لا سيفًا على أيهما.
يا شباب الحركة… اسألوا، فالسؤال وقود البحث لا عنوان التمرد.
ويا شيوخ الحركة… أعطوا للشباب فرصة أن يُدهشونكم كما أدهش مصعب المدينة كلها.
ويا أصحاب “القلبين” الذين يقفون بين الضفتين… لا تتركوا الجسر يسقط، فالدعوة لا تسير إلا بكم، ولا يُقام البناء إلا حين تتشابك الأيدي كلها… من يحمل المطرقة، ومن يحمل المخطط، ومن يحمل التجربة، ومن يحمل الشعلة.
وحين تُبنى هذه الجسور، تهدأ الفتنة، ويعود الشباب إلى أماكنهم دون قسر، ويستفيد المحافظون من طاقة التجديد دون خوف، ويتحوّل الصدام إلى تكامل، ويصبح الخلاف وقودًا للنهضة لا نارًا في الهشيم.
فما بين ضجيج الشاشات وضجيج النفوس، وما بين همّ المجتمع وهمّ الدعوة، تبقى التربية هي اليد الوحيدة القادرة على جمع الإخوة المختلفين، وردّ الشارد، وتهدئة الغاضب، وإحياء الجذور التي تنبت منها أجيالٌ لا تخاف السؤال، ولا تهدم الأصل، ولا تقطع الطريق بين الماضي والمستقبل.
إنها الكلمة اللينة، والقدوة الحية، والصدر الرحب… هي وحدها التي تقدر على ردم الفجوة، وتهذيب العقول، وتليين القلوب حتى تعود الأمة بيتًا واحدًا، مهما اتسعت سماؤه وتعدّدت نوافذه.
هذه سنّة الدعوات… وهذا طريق النهضة… وهذا وعد الله لمن {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} أن يستخلفهم في الأرض متى اتحدت قلوبهم قبل خطواتهم.