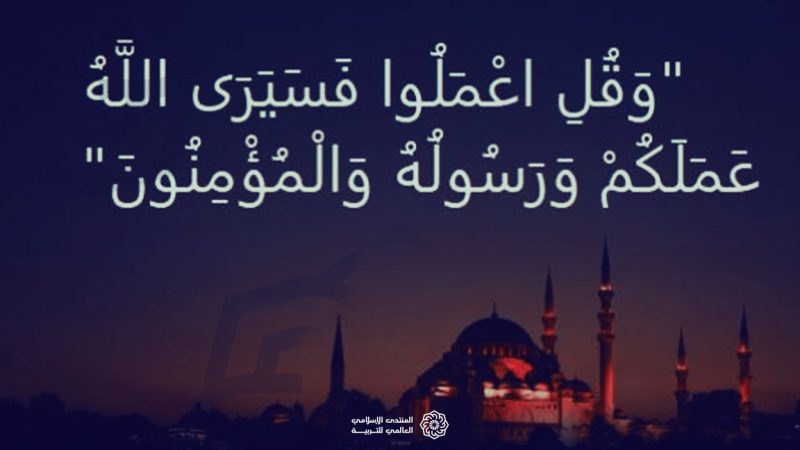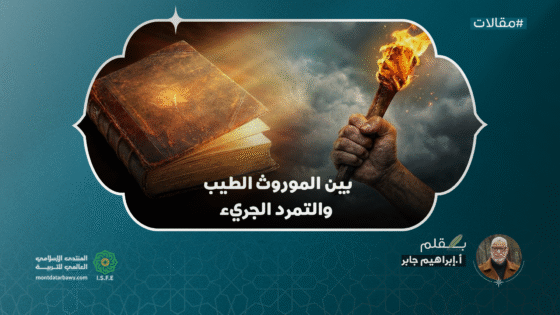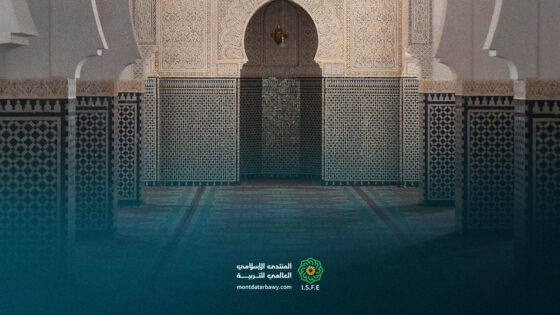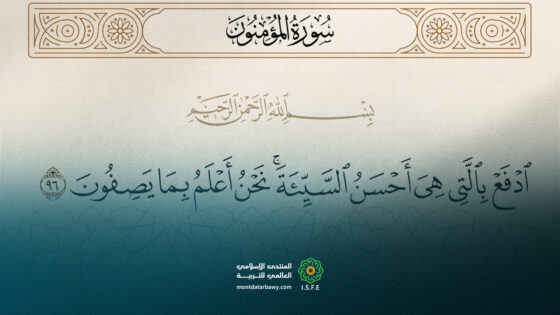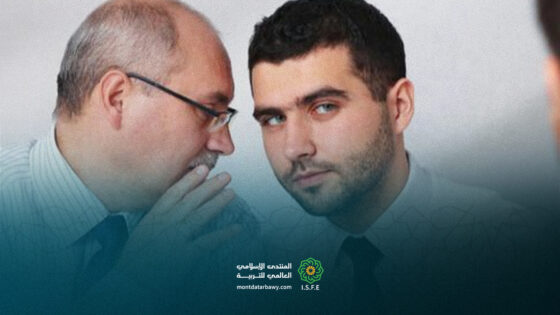إن الإسلام بتشريعاته المتوازنة وتعاليمه السّمحة دين نظام وانضباط، فهو يجمع بين العمل والعبادة في توازن دون تعارض، وكذلك الأمر بين الروح والجسد، والعقل والنقل، والمادية والروحية، يقول الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (سورة القصص: 77].
والإسلام يقوم على صلة العبد بربه وخالقه، لإحياء روحه وقلبه بأشعة الإيمان ونور اليقين، ويهتم بعمارة الحياة الدنيا وإصلاحها، واستخراج الرزق من ثناياها دون أن يطغى جانب على آخر.
التوازن بين العمل والعبادة في الإسلام
لقد اهتم الإسلام بالتوازن بين العمل والعبادة من منطلق قاعدتين أساسيتين؛ ففيما يخص العمل والكسب، حرص على عمارة الأرض واستخراج الرزق من ثناياها، والسير فيها بالحق والخير والعدل والإحسان بين الناس جميعًا، وفيما يخص العبادة أكد أنها صلة العبد بربه وخالقه، لإحياء روحه وقلبه بأشعة الإيمان ونور اليقين وكشف الغطاء عن فطرته الصافية وإنسانيته النقية، فيعيش في إطار الحب والمراقبة وفي جنبات الطهر والصفاء.
ولا شك أن العبادة هي وقود العمل وميزانه ونوره ودستوره القويم الذي لا تزيغ معه الأهواء ولا تشرد به العقول والأفكار، أو تضل به الدروب، وبالتالي فإن القاعدتين في الإسلام تشبع في الإنسان ملكاته ورغباته ونزعاته وتخاطب فيه قواه الحيوية وتوجهاته البشرية، فيعمل بكل طاقته وينطلق بكل إمكاناته بغير قُصور أو قُيود أو سُدود أو التواء أو أخطاء، فلا رهبانية في الإسلام ولا قعود عن جلائل الأعمال أو إهلاك للطاقات الحيوية والابداعية في الفرد.
إنّ الغاية بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في الإسلام، مبنية على توازن يُواكب فطرة الإنسان ويحقق رسالته في الحياة ويؤكد خلافته الصالحة فيها، دون تفريط في كل ما فيه رفاهية، يقول تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا) [الفرقان: 67].
وعن أنس- رضي الله عنه- قال: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يَسْأَلُونَ عن عِبَادَةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، قالَ أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ ولَا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهِم، فَقالَ: أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَذَا؟! أَمَا واللَّهِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقَاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي” (متفق عليه).
هكذا نجد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- سارع لتدارك خطأ جسم كان سيقع فيه الثلاثة رهط، وهو القضاء على الحركة الحيوية في الإنسان وإضعاف القوى الاقتصادية والبشرية باسم الدين والعقيدة، فأقر الرسول الكريم القواعد الصحيحة للرسالة السامية والعبادة الصحيحة للمنهج السليم.
ولم تخلُ أحاديث النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الإشادة بالعاملين لكسب قوت يومهم، فقال- صلى الله عليه وسلم-: :”ما من مسلمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أو يَزْرَعُ زَرْعًا فيَأْكُلُ منه طيرٌ ولا إنسانٌ إلا كان له به صدقةً” (البخاري). وقال- صلى الله عليه وسلم-: “ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ” (البخاري).
وعمل الإنسان في معاشه عبادة بشروط:
1- أن يكون العمل مشروعًا في نظر الإسلام.
2- أن تصحبه النية الصالحة.
3- أن يؤدي العمل بإتقان وإحسان.
4- أن يلتزم فيه حدود الله.
5- ألا يشغله عمله الدنيوي عن واجباته الدينية. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (المنافقون: 9)، وقال عز وجل: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (النور:37).
إذا رعى المسلم هذه الأمور كان سعيه عابدًا، وإن لم يكن في محراب مبتهلًا إلى الله، وإن لم يكن في صومعة.
وقد جاءت أحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- تبين أن العمل المباح لتحصيل الرزق، متى قصد به طاعة الله تحول إلى قربة وعبادة يثاب عليها صاحبها، من ذلك ما رواه الطبراني.
عن كعب بن عُجْرة قال: “مر على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ فرأى أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من جلَدِه ونشاطِه فقالوا: يا رسولَ اللهِ لو كان هذا في سبيلِ اللهِ؟! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إنْ كان خرج يسعى على ولدِه صغارًا فهو في سبيلِ اللهِ وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيلِ اللهِ وإنْ كان خرج يسعى على نفسِه يعفُّها فهو في سبيلِ اللهِ وإنْ كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيلِ الشيطانِ.”.
وباشر الصحابة الأعمال وتاجروا، حتى ألصق النّاس بالنبي- صلى الله عليه وسلم- وهو سيدنا أبو بكر الصديق، الذي لم يمنعه حُبّه للنبي- صلى الله عليه وسلم- من الكسب والتجارة، فسافر إلى بصرى في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-.
وطبّق الصحابة- رضوان الله عليهم- هذا التوازن بين جمع العلوم الشرعية وحفظ القرآن وأحاديث النبي- صلى الله عليه وسلم-، وبين التجارة والعمل، فلم يركنوا للدنيا، وفي الوقت نفسه لم يجلسوا في المساجد فحسب، وهو التوازن الذي يجب أن يجتهد المسلم في التوفيق له.
أسباب عدم التوازن بين العمل والعبادة
يعود عدم التوازن بين العمل والعبادة إلى العديد من الأسباب، منها:
1. عدم الفهم الصحيح للغاية من خلق الإنسان التي تجمع بين طاعة الله، وتعمير الأرض، والاستخلاف فيها.
2. التباس بعض المعاني على بعض الناس ما يجعلهم يزهدون في العمل من أجل الرهبنة في العبادة، كالثلاثة الذين أقسموا أن لا يتزوجوا ولا يناموا، ولا يفطروا؛ فصحح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم الحياة الحقيقية والتوزان بين الحياة والتمتع بها وبين العبادات، وهو المعنى الذي ذكره الله سبحانه في قوله: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}(القصص: 77).
3. التنطع والتشدد أو التميّع في تغليب جانب من جوانب الحياة على الجوانب الأخرى.
4. ضعف الإيمان، والاهتمام بالدنيا دون الدين وأوامره ونواهيه، وعدم مراعاة الآخرة، والافتتان بالحياة الدنيا، والسعي من أجل الحصول على المال بأي وسيلة، دون إعطاء الروح والنفس غذاءها الروحي والتربوي.
كيف نربي أنفسنا وأبناءنا على التوازن بين العبادات والعمل؟
لقد نظم الشرع الحنيف العلاقة بين العمل والعبادة بكل وضوح حتى لا يطغى جانب على آخر فتفسد حياة الإنسان والناس. والأبناء يقلدون آباءهم وأمهاتهم فيما يرونه منهم إن كان خيرًا فخير، وإن كان شرًا فشر، ولذا، على الوالدين الحرص على تربية أبنائهم على حب التوازن بين عبادتهم وطاعتهم لله وبين معاشهم وسعيهم من أجل العمل والكسب، وذلك بالتزام عدة أمور:
1. تطبيق أحكام الشريعة في الأمور الدنيوية، فهي لم تأتِ بأحكام الصلاة والصيام والحج والذكر والدعاء وتلاوة القرآن فقط، وإنما جاءت- أيضًا- بأحكام مُتعدّدة في النكاح والطلاق والحضانة والرضاع والبيع والشراء والوكالة والكفالة والرهن والإجارة والحوالة، وغير ذلك.
2. ينبغي أن يعمل الإنسان في مجال مباح ومشروع؛ فلا يعمل في حرام أو محظور، ما يسبب له غشاوة في القلب وضعفًا في الإيمان.
3. أن لا يجعل المسلم الدنيا في قلبه، مع عمله فيها وسعيه من أجل تعميرها ونشر الخير بين الناس فيها.
4. أن يدرك المسلم أنه لا بد له من عبادة الله، كما لا بد له من البيع والشراء: {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ} [النور: 37]. فالمسلمون يجب أن لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم.
5. إخراج حقوق الله من ممتلكاته، وتسليم حق المال؛ زكاة المال، وحق الزرع، وأن يقصد بتجارته أو عمله وجه الله.
6. ضرورة توفير البيئة والصحبة الصالحة لأبنائنا في البيت والمسجد والشارع والمدرسة، وتوفير القدوة الحسنة من نفسك، في التوازن بين العبادات والأعمال الدنيوية، ومراقبة الأبناء ومتابعتهم برفق وحزم، وعدم تركهم نهبًا للإهمال والدلال الزائد، وتعويدهم على تحمل المسؤولية.
7. عدم التمييز بين الأبناء أو تركهم نهبًا لصحبة وبرامج السوء في وسائل التواصل والإعلام، وحثهم على حفظ القرآن وطلب العلم النافع والعمل الصالح، وذكر الله تعالى وقراءة القرآن، والاعتماد على النفس في الكسب والعمل متى أصبحوا مؤهلين لذلك.
8. اعتماد أسلوب الترغيب والتحفيز والتشجيع، ومراعاة المراحل العمرية للأطفال، وتعليمهم كيفية تنظيم الوقت، والانضباط، والموازنة بين اللين والشدة.
9. تشجيعهم على التفوق في دراستهم وحياتهم، وأن ذلك من صميم الدين ومن الأمور التي يحصل منها المسلم على الكثير من الحسنات والثواب الجميل من الله.
10. عمل حلقات تربوية ودراسة نماذج ناجحة جمعت بين العمل والعبادات ونجحت فيها، ككثير من الصحابة الذين نجحوا في تجارتهم وامتلكوا الثروات؛ ومع ذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لحسن قربهم من الله.
إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة، وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا، وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة، كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا، وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض، كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي، هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية.
ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج الله الذي رضيه للناس؛ فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبادة، وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة، والمنهج الإسلامي بهذا يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق؛ فلا يفوِّت على الإنسان دنياه لينال آخرته، ولا يفوِّت عليه آخرته لينال دنياه؛ فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي.
المصادر والمراجع:
- العبادة في الإسلام. د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة- القاهرة.1416=1995.
- العبودية . ابن تيمية. تحقيق. عبد الرحمن الباني. ط7. بيروت. 1426=2005.
- في ظلال القرآن. سيد قطب. تفسير سورة المائدة، الآية 66.
- التوازن بين العمل والعبادة . تيار الإصلاح. 7 أبريل 2022.
- التوفيق بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. محمد صالح المنجد.18 شوّال 1424هـ.
- كيف نربي أبناءنا على حب العبادات؟ الشيخ أحمد العقيلي. 10 ديسمبر 2021