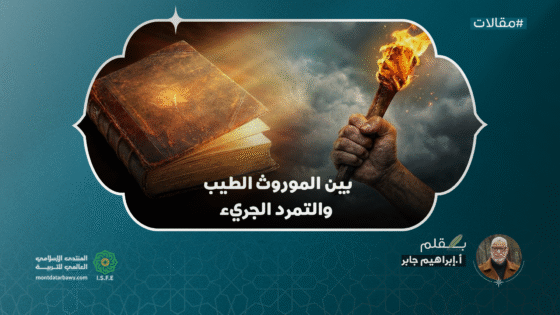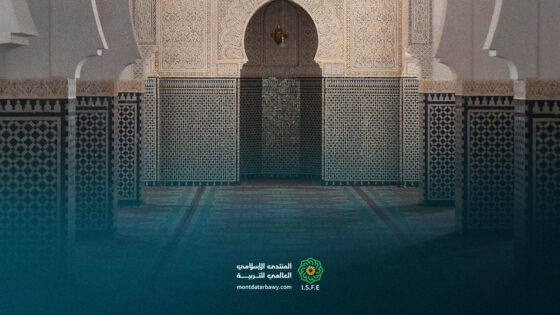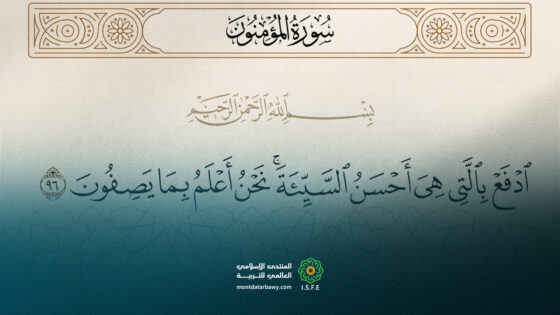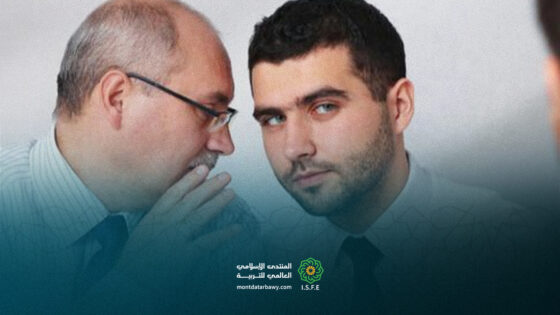الشكر لله عبادة قلبية، تزيد النعم وتدفع النقم، وهي عظيمة القدر، تفيض آثارها الجميلة على اللسان، فيلْهَج بالحمد والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال، ويظهر آثارها على الجوارح، فتزداد عملًا بطاعة الله تعالى، واجتهادًا في طلب مرضاته، مع تسخير النعم فيما يكون مرضيًا لله سبحانه وتعالى، وإذ صدر الشُّكر من العبد مقابل ما يقع له من المصائب، فإن ذلك يعد من أعلى درجات العبودية، ولا يصل إليه إلا خواص المؤمنين، وعباد الله المتقين.
وتربية النفس على شُكرُ النعمة تتم بأمور منها، أن ننسبها إلى الله سبحانه، ونشكره عليها، ونحسن استخدامها، في مرضاته وعدم الإسراف فيها، ولقد قرن الله هذا العمل القلبي بكثيرٍ من النعم التي أنعم بها على الناس، قال- عز وجل-: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) [البقرة:152]. وقال تعالى: (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ) [النساء:147].
مفهوم الشكر لله وتأصيله شرعا
ويأتي معنى الشكر لله في اللغة من مصدر شَكَرَ، والشّكر من الله: يعني الرضا والثواب، ويُعرّف بأنّه عِرفان النعمة وإظهارها والثناء بها. وقال الراغب: الشُّكر تصور النِّعمة وإظهارُها، وقال ابن منظور: الشُّكر عِرفانُ الإحسان ونشرُه، والشُّكر من الله: المجازاةُ والثناءُ الجميلُ.
وفي الاصطلاح: هو الاجتهاد في بذل الطاعة، مع الاجتناب للمعصية، في السر والعلانية. وقال بعضهم: هو الاعتراف بالتقصير في شكر المنعم. وقال الفراء: معرفة الإحسان، والتحدث به، فهو إذن ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه إيمانًا، وفي جوارحه عبادة وطاعة وفي لسانه حمدا وثناءً.
وجاء الشكر في مواطن عديدة من القرآن الكريم، من ذلك قول الله- سبحانه وتعالى-: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) [البقرة:152]، حيث قرن الله ذكره بشكره وكلاهما المراد بالخلق والأمر والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعون عليهما.
وقرن الله- عز وجل- الشُّكر بالإيمان، وأنه لا غرض له في عذاب الخلق إذا قالوا آمنا: (مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ)[النساء: 147]، أي وفّيتم حقه وما خلقتم من أجله وهو الشُّكر بالإيمان.
وأهل الشُّكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، لقوله سبحانه: (وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ) [الأنعام:53].
وقَسّم الله- جل وعلا- الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكُفر وأهل الكُفر، وأحب الأشياء إليه الشُّكر وأهل الشُّكر، قال تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) [الإنسان:3].
ولقد وعد الله- تبارك وتعالى- الشّاكرين بالزّيادة والنماء في كل شيء، قال تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) [إبراهيم:7].
ولأهمية الشكر، كانت أول وصية أوصى الله بها الإنسان بعدما عقل، أن يشكر له ثمّ لوالديه: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) [لقمان: 14].
وفصّلت السنة النبوية الشريفة كيفية الشكر الله سبحانه وتعالى، فهو إما بالقلب، حيث يجب على المسلم أن يعلم بأن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها، وليس أي إنسان مهما بلغ من الغنى، لقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) [فاطر:3].
وعن صهيب الرومي- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: “عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له” (مسلم)، ويكون ذلك بالقلب واللسان.
والشكر يكون باللسان، فالمرء يُعرب عما في قلبه، فإذا امتلأ القلب بالشُكر، لهج اللسان بحمده والثناء عليه، وقد جاء في أذكار النبي- صلى الله عليه وسلم، من الحمد والشكر لرب العالمين، فكان- صلى الله عليه وسلم- إذا استيقظ من نومه يقول: “الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور” (البخاري)، وأمرنا بأن نقول هذا الدعاء: “الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره” (الترمذي وحسنه الألباني).
وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: “إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها” (مسلم).
وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أنَّ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان إذا أوى إلى فراشِه قال: “الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِيَ” (صحيح ابن حبان).
وقال الرسول- صلى الله عليه وسلم-: “من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته” (أبو داود وابن حبان).
وعن عائشةَ- رضي الله عنها- قالت: فقَدتُ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ذاتَ ليلةٍ من الفِراشِ فالتمستُه في البيتِ وجعلتُ أطلبُه بيدي، فوقعتْ يدي على قدمَيْه وهما مُنتصِبتان وفي حديثِ قاسمٍ: منصوبتان وهو ساجدٌ فسمِعتُه يقولُ: “أعوذُ برِضاك من سَخَطِك وبمعافاتِك من عقوبتِك وأعوذُ بك منك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيْتَ على نفسِك” (مسلم).
والشُّكر يكون بالجوارح، بالتصدّق عن كل مفصل، فعن أبي ذر الغفاري- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: “يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى” (مسلم).
ويكون الشكر بالسجود لله، فعن أبي بكرة بن الحارث- رضي الله عنه-، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- “أنَّهُ كانَ إذا جاءَهُ أمرُ سرورٍ أو بشِّرَ بِهِ خرَّ ساجدًا شاكرًا للَّهِ” (صحيح أبو داود).
وقد كان الشُّكر ديدن الصحابة والتابعين من بعدهم، فها هو أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- لما جاءه خبر مقتل مسيلمة المرتد الذي ألب عليه العرب، وكان من أشد الناس على المسلمين، خر ساجدًا.
وقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي حَازِمٍ (سلمة بن دينار): “مَا شُكْرُ الْعَيْنَيْنِ يَا أَبَا حَازِمٍ؟ قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ بِهِمَا خَيْرًا أَعْلَنْتَهُ، وَإِنْ رَأَيْتَ بِهِمَا شَرًّا سَتَرْتَهُ، قَالَ: فَمَا شُكْرُ الْيَدَيْنِ؟ قَالَ: لَا تَأْخُذْ بِهِمَا مَا لَيْسَ لَهُمَا، وَلَا تَمْنَعْ حَقًّا لِلَّهِ هُوَ فِيهِمَا، قَالَ: فَمَا هُوَ شُكْرُ الْبَطْنِ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَهُ طَعَامًا، وَأَعْلَاهُ عِلْمًا، قَالَ: فَمَا شُكْرُ الْفَرْجِ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6] إِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] قَالَ: فَمَا شُكْرُ الرِّجْلَيْنِ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ حَيًّا غَبَطْتَهُ اسْتَعْمَلْتَ بِهِمَا عَمَلُهُ، وَإِنْ رَأَيْتَ مَيِّتًا مَقَتَّهُ كَفَفْتَهُمَا عَنْ عَمَلِهِ، وَأَنْتَ شَاكِرٌ لِلَّهِ، فَأَمَّا مَنْ شَكَرَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَشْكُرْ بِجَمِيعِ أَعْضَائِهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ كِسَاءٌ، فَأَخَذَ بِطَرْفِهِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ، فَلَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ مِنَ الْحَرِّ، وَالْبَرَدِ، وَالثَّلْجِ، وَالْمَطَرِ”.
وعن عمرو بن السكن قال: كنت عند سفيان بن عيينة، فقام إليه رجل من أهل بغداد؛ فقال: يا أبا محمد، أخبرني عن قول مطرف: لأن أعافى، فأشكر؛ أحب إلي: من أن أبتلى، فأصبر؛ أهو أحب إليك، أم قول أخيه أبي العلاء: اللهم، رضيت لنفسي ما رضيت لي؟ قال: فسكت سكتة؛ ثم قال: قول مطرف أحب إلي؛ فقال الرجل: كيف، وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له؟ قال سفيان: إني قرأت القرآن، فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان فيها: {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ووجدت صفة أيوب مع البلاء الذي كان فيه: {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}، فاستوت الصفتان، وهذا معافى، وهذا مبتلى؛ فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر؛ فلما اعتدلا: كانت العافية مع الشكر، أحب إلي، من البلاء مع الصبر.
وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: لما قال سفيان الثوري: لا أقوم حتى تحدثني، قال له: أنا أحدثك، وما كثرة الحديث لك بخير؛ يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة، فأحببت بقائها ودوامها: فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله- عز وجل- قال في كتابه: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}، وإذا استبطأت الرزق: فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال في كتابه: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً}، يا سفيان، إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره، فأكثر من: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج، وكنز من كنوز الجنة؛ فعقد سفيان بيده، وقال: ثلاث، وأي ثلاث؟ قال جعفر: عقلها والله أبو عبد الله، ولينفعنه الله بها.
وقال الإمام الغزالي- رحمه الله-: “الشكر ينتظم من علم وحال وعمل، فالعلم معرفة النعمة من المُنْعِم، والحال الفرح الحاصل بإنعامه مع الخضوع والتواضُع، والعمل القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه، ويتعلَّق ذلك العمل بالقلب، وبالجوارح، وباللسان، أما القلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق، وأمَّا باللسان فإظهارُ الشكر لله بالتحميدات الدالَّة عليه، وأمَّا الجوارح فاستعمال نِعَم الله في طاعته والتوقِّي من الاستعانة بها على معصيته حتى إن مِن شُكْر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، وشُكْر الأذنيين أن تستر كل عيب تسمعه فيه”.
وسائل تربوية تُعين على الشكر لله
وهناك وسائل تربوية تعين المسلم على عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى، من ذلك:
- التأمل في نعم الله، واستحضارها في كل لحظة وحين، وعدم الغفلة عنها، فإن كثيرًا من الناس يتنعمون بشتى أنواع النعم من مآكل، ومشارب، ومراكب، ومساكن، ومع ذلك لا يستشعرون هذه النعم، لأنهم لم يفقدوها يومًا من الأيام، واعتادوا عليها، لذلك فإن الله يريد منا التأمل في هذه النعم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3].
- أن ينظر كل واحد منا إلى من هو أسفل منه، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: “انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم” (البخاري ومسلم).
- أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسأله يوم القيامة عن شكر هذه النعم، هل قام بذلك أو قصر؟ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 8].
- قراءة القرآن وتدبر آياته، لأنها من الذكر الذي يدخل في باب الشُّكر باللسان، وقد أمر الله تعالى عباده بتلاوة القرآن وتدبره حتى لا ينقطع الحبل بين العبد وربه، ويبقى القلب موصولاً مع الله أبدًا، فيتجنب العبد المنعَم عليه حينها البطر والاستعلاء على الناس، ويخاف أن يتعرض لحقوقهم ودمائهم وأموالهم.
- معرفة أن الله يحب الشكر، لقول قتادة: “إن ربكم منعم يحب الشكر”.
- تخصيص أوقات لزيارة المرضى وأهل الفاقة والبلاء، حتى نعلم قيمة نعم الله علينا، فنشكره باللسان والقلب والجوارح.
- التفكّرُ في نعم الله تعالى التي لا يستطيع العبد أن يحصيَها، كالإيمان، والسلامة، والأمن، والصّحة في البدن، والسلامة في المال، ونعمة الأهل والولد، والتفكر في عدم قدرته على أداء حق الله تعالى، وعجزه وغفلته عن ذلك، فما لذلك سبيل سوى الاجتهاد في الشُّكر.
- الصدقة والبذل والعطاء، فإن ذلك من علامات شكر النعم وشكر المنعم بها.
- السجود شُكرًا لله فور تلقي الخبر السّار أو حصول النِّعمة أو دفع البلاء؛ وتكون سجدة من غير صلاةٍ، ولا يشترط فيها الوضوء أو التوجه إلى القِبلة أو الطّهارة؛ فيسجد المسلم على الحال الذي هو عليه.
- التواضع وترك الكبر الذي هو مضاد للشكر، فالشاكر يعترف بأنّ كل نعمة إنما هي من الله وليس له دخل في وجودها.
- أن ندعو الله أن يعيننا على الشكر: “اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” (أبو داود وصححه الحاكم).
ثمرات شكر الله
وتتعدد ثمرات الشكر لله سبحانه، ومن ذلك ما يلي:
- نيل رضى الله، قال تعالى: (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) [الزمر: 7].
- زيادة النعم: قال الله تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) [إبراهيم: 7].
- دوام النعم: قال عمر بن عبد العزيز- رحمه الله-: “قيّدوا النعم بالشكر”.
- دخول الشاكر في قائمة المؤمنين: لأنّ العبد المؤمن يتميّزُ بشكر الله تعالى على كلّ ما يصيبه، إن كان خيرًا فرح وشكر، وإن كان شرًا احتسب وصبر، فهو يعلم أنّ كلّ ما يأتي من الله هو خيرٌ له وإن كان ظاهره شرًا.
- اكتسابُ الأجر في الآخرة: لا تقتصرُ مكافأة الله لعبده الشكور على حدود الحياة الدنيا، إنما تجتازُها لينالَ الأجرَ والجزاء العظيمَ منه تعالى في الآخرة. فهو سبحانه القائل: (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ)، [آل عمران: 145].
- أمان من العذاب: لأنّ العبد الشكور ينجيه اللهُ- عزّ وجل- من العذاب كما ينجي المؤمن بسبب إيمانه. قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ [النساء: 147].
- يجعل الإنسان مقتديا بالأنبياء الكرام فهم أهل الشكر، حيث عاش النبي- صلى الله عليه وسلم- حياته شاكرا لله تعالى، حامدا له، راضيا عنه، مبلغا دينه، صابرا على الأذى فيه، قانعا من الدنيا بالقليل؛ وكذلك الأنبياء قبله، قال تعالى: (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) [الإسراء: 3] وقال سليمان- عليه السلام- (هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) [النمل: 40].
- زيادة قوة الإيمان: قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) [إبراهيم:5].
إنّ الشكر لله غاية الخلق، وهو اعتراف بالمنعم والنعمة، بل هو سبب من أسباب حفظ النعمة وزيادتها، لأن الله هو الذي تفضّل على عباده بالنِّعم التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، وفضّل بني آدم على سائر المخلوقات وحباهم بالنِّعم؛ فمن تفضّل علينا بالنِّعم ووهبنا إيّاها من غير حولٍ منا ولا قوة لزمنا شُكره جل وعلا.
المصادر والمراجع:
- الراغب الأصفهاني: المفردات، ص 265.
- ابن منظور: لسان العرب 4 /2305-2308.
- القرطبي: تفسير القرطبي 1/438.
- ابن القيم: مدارج السالكين 2/244.
- محمد شمس الحق: عون المعبود 7/328.
- ابن أبي الدنيا: الشكر، ص 129.
- الطبري: تفسير الطبري 6/218.
- الغزالي: إحياء علوم الدين 4/ 72 – 74.
- أبو نعيم: حلية الأولياء 2/ 212 – 213.
- المصدر السابق: 3/ 193.